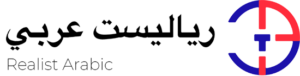دمشق – (رياليست عربي): تثير التطورات الدرامية للأحداث عند الحدود الروسية – الأوكرانية تساؤلات مشوبة بقلق مشروع حول مدى عمق الخلافات بين بلدين جارين شاءت التجاذبات الداخلية والصراعات الإقليمية والدولية أن تضع علاقاتهما التاريخية أمام معادلة صعبة، لا تتعلق بمحاولة إيجاد صيغ لنزع فتيل التوتر بينهما فحسب، بل كذلك بالبحث عن أسباب نشوء نزاعات دورية بين معظم بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
إذ يكفي أن ننظر إلى ما آلت إليه أوضاع تلك الدول خلال العقود الثلاثة الأخيرة حتى ندرك أن تداعي البيت السوفييتي لم يكن إلا بداية أزمات بنيوية حادة تكشفت أثناء بحث كل بلد منها عن هويته الجديدة وموقعه الخاص بين صفوف المجتمع الدولي، وتمثلت بتعثر هذه البلدان في إنشاء منظومات سياسية مستقرة عقب حصولها على السيادة الوطنية المنشودة، ما أدى إلى انفجارات مدوية للأسئلة المؤجلة إبان الحقبة السوفيتية، كلّفت روسيا وأخواتها أثماناً باهظة جداً، إما على شكل حروب أهلية طاحنة أو نزاعات مريرة فيما بينها على حد سواء.
وإذا كان تشابك العلاقات والمصالح بين بلدان شكّلت حتى أمد قريب فضاءً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً واحداً، قد أملى عليها ضرورة استمرار التقارب فيما بينها، فإن سعيها نحو هذا الهدف الذي تفرضه اعتبارات جيوسياسية وديموغرافية ما زال يصطدم بعوائق شتى، أدت وتؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، وما الحروب التي تدور رحاها من حين إلى آخر بين ” الأخوة – الأعداء”، إن صح التعبير، إلا دليل ساطع على ذلك.
عقب انهيار بيتها المشترك وتبعثره، بحثت هذه البلدان عن مكان لائق لها تحت مظلة المجتمع الدولي، كدول مستقلة ذات سيادة، وظهرت بوادر “ترميم” البناء القديم، لكن الزمن كان قد فعل فعله، فتركت عوامل “الحت والتعرية” بصماتها الواضحة على جدرانه وغمرت المياه الآسنة أساساته المتضعضعة، أما ما تبقى منه فأصبح هشيماً تذروه رياح التغيير، وانقلبت التحولات العاصفة التي جرت آنذاك وبالاً على شعوب منطقة ” أوراسيا” بأسرها، إذ لم تكن النخب الحاكمة قادرة ـ بنيوياً ـ على إنشاء منظومات سياسية مستقرة على أسس الحرية والديمقراطية المنشودة، كما لم تتمكن من الانتقال بمجتمعاتها إلى اقتصاد السوق والليبرالية الاقتصادية، سواء بطريقة تدريجية أو عن طريق العلاج بالصدمة، فعمّت الفوضى واستشرى الفساد على خلفية عمليات خصخصة مجحفة حيّدت شرائح واسعة من أبناء المجتمع ما بعد السوفييتي وأبعدتها عن وسائل الإنتاج، وقسمت الثروات الوطنية الهائلة بين قوى اقتصادية ومالية قفزت فجأة إلى المشهد الاقتصادي وعملت جاهدة عبر وسائل الإعلام على ترسيخ رؤاها الخاصة لبناء مجتمع حديث يتساوى فيه المجرم والضحيّة في ظلّ انعدام القانون وسيطرة عالم الجريمة المنظمة على مقدرات البلاد بشكل عام.
في هذه الأجواء الملبّدة بغيوم أسئلة هطلت بغزارة على تربة غمرتها وُحول البؤس وامتهان الكرامة الإنسانية، كان لا بد من توقع ردود فعل متباينة الرؤى والأهداف على الإصلاحات في بلدان ” رابطة الدول المستقلة”، وطالبت الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية بأطيافها المختلفة بضرورة تحويل الصراع السياسي إلى المجرى الذي يضمن التداول السلمي للسلطة ويعزز الأمن والاستقرار ويساهم في تحسين المناخ الاستثماري تمهيداً لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الواعدة في هذه البلدان، بينما كانت المؤسسات الاقتصادية وبيوت المال العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تستعد لأن يدق قادة البلدان المتعثرة أبوابها موافقين على وصفاتها المعروفة.
كشف التطور اللاحق للأحداث أن المقولات الإيديولوجية التي حكمت تلك البلدان على مدى عقود من الزمن لم تعد مؤهلة لمواجهة تسونامي الأزمات المتعاقبة، ولكن على الرغم من ذلك، استطاعت بُنى الدولة العميقة أن تعيد إنتاج نفسها مؤكدة قدرتها على اجتراح المعجزات للبقاء في السلطة، فعادت ـ بعد حصولها على الشرعية “الصورية” في بلدانها ـ للانخراط في “لعبة الأمم” وفق سياقات إقليمية ودولية محددة لم تُراعِ فيها مصالح حلفاء الأمس، خصوصاً عقب صعود ممثلي الأفكار القومية المتطرفة إلى مفاصل هامة في السلطة، وظهور قوى جديدة فاعلة على المسرح السياسي نشأت وترعرعت بعيداً عن “الحضن السوفييتي” بدا لها أن مفاهيم مثل استراتيجيات الأمن القومي أو الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما هي إلا قوالب نمطية تهدف إلى ترسيخ هيمنة دول عظمى على بلادها، أما الادعاءات بشأن ترسيم حدود، أو استعادة مناطق، أو غير ذلك، فما هي إلا حجة للإبقاء على هذه الهيمنة، وعوضاً عن الدعوة إلى البحث المشترك عن حلول لأزماتها المتفاقمة، ارتفعت أصوات في بعض هذه الدول تؤكد أن الوقت قد حان للخروج من معطف روسيا الثقيل والتوجه غرباً أو شرقاً، ظناً منها أنها سوف “تصنع الفارق” في العلاقات الدولية التي تتسم بالبراغماتية الصرفة.
أما بالنسبة إلى روسيا، فلا يمكن لها أن تسلّم باصطفاف جديد للقوى الإقليمية والدولية عند حدودها مهما كلف الثمن، الأمر الذي يبرر نبرة خطابها السياسي العالية على الساحة الدولية. ومن نوافل الحديث عن أسباب تصعيد حدة التوتر في الصراع الدولي الحالي على خلفية التنافس التقليدي الذي ما زال يحكم عقلية الإدارتين الروسية والأمريكية، مهدداً بالعودة إلى أجواء الحرب الباردة، ولكن بأسوأ أشكالها في وقت تمر فيه البشرية بمحن فظيعة، مثل وباء “كوفيد “19، ووحش الإرهاب الدولي الذي مازال يطلّ برأسه من مغارته القديمة، وارتفاع موجات التعصب القومي والفكر الديني المتطرف، والتهجير القسري لملايين البشر جرّاء الحروب الأهلية، واستمرار النزاعات المسلحة بين بلدان ترتبط فيما بينها بعرى تاريخية واجتماعية وثيقة، بالإضافة إلى انسداد الأفق السياسي والاقتصادي أمام أعداد ضخمة من الشباب الذي يعيش حالة تهميش وبطالة وعوز، الأمر الذي يقتضي ضرورة إيجاد وسائل لإخماد نيران هذه الأزمات وليس العكس، فلا أحد في هذا العالم، أفراداً أو شعوباً أو دولاً، محصناً ضد الكوارث والعذاب الإنساني ما دمنا نعيش في عالم مهووس بالقوة، يصدّر فائضها ويبلي الآخرين بها بحروب عبثية تحصد أرواح الأبرياء الذين كانوا يحلمون بحياة أكثر عدالة واحتراماً لكرامة الإنسان. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه، مرة على شكل مأساة وأخرى على شكل ملهاة، فليس أصعب من أن تفتح إحدى صفحاته لتجد أنك قرأتها أو عشتها مرات ومرات.
خاص وكالة رياليست – د. نواف القنطار – كاتب ومترجم وباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية الروسية.