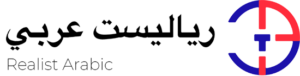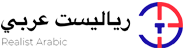يصادف العاشر من آب (أغسطس) 2020 مرور 100 عام بالضبط على التوقيع في سيفر (فرنسا) على المعاهدة بين الفائزين في الحرب العالمية الأولى – دول الوفاق وممثلي الإمبراطورية العثمانية. وقد استند إلى اتفاقية سرية عرفت باسم مؤلفيها: الإنجليزي سايكس والفرنسي بيكو ، اللذين حددا في عام 1916 ملامح الدول المستقبلية على الخريطة على أجزاء من الإمبراطورية العثمانية.
في عام 1923 ، أوضحت قرارات مؤتمر لوزان حدود الدول الجديدة من شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية إلى اليونان وأرمينيا. وإذا كانت إمكانية إنشاء دولة كردية في سيفر لا تزال منصوصًا عليها ، فعندئذ في لوزان ، تحت ضغط السلطات التركية الجديدة ، اختفت هذه الفقرات من نص المعاهدة. حتى الإمارات والإمارات والممالك الكردية التي كانت موجودة في وقت سابق تحت حكم العثمانيين ألغيت تدريجياً.
كان العيب الرئيسي لهذا ، وهو أحد المعاهدات الأخيرة لنظام فرساي بشأن إعادة التقسيم التالية للعالم ، هو الجهل بمصالح العديد من شعوب الشرق الأوسط وغرب آسيا. إذا كانوا جميعًا في الإمبراطورية العثمانية يدفعون الضرائب لإسطنبول ، وكانوا رعايا للسلطان على قدم المساواة ، فإن إنشاء دول جديدة من قبل بريطانيا العظمى وفرنسا كان مصطنعًا إلى حد كبير ، في صمت المكاتب على طول الخطوط المرسومة على الخريطة الجغرافية ، أدى إلى الاستيلاء التدريجي للسلطة فيها من قبل الشعوب أو الأمم ( الأتراك والعرب). وجدت العشرات من الجماعات العرقية أو المذهبية الأخرى في المنطقة نفسها في الدول الجديدة كأشخاص من الدرجة الثانية أو أقليات مضطهدة.
فضل المستعمرون الغربيون الجدد ، الذين حصلوا على تفويض من عصبة الأمم لحكم هذه الأراضي، الاعتماد في سياساتهم على النخب المحلية في دمشق وبغداد ولم يترددوا في اللجوء إلى الطريقة المجربة والمختبرة للحكم الاستعماري “فرق تسد”. قمع ممثلو بريطانيا العظمى وفرنسا كل الاضطرابات والانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط وغرب آسيا بالقوة العسكرية ، بما في ذلك بمساعدة وكلائهم.
مثل هذه السياسة الأنانية وقصيرة النظر كانت بمثابة “قنبلة موقوتة”. بعد أن أُجبرت الدول الغربية على منح الاستقلال للدول الجديدة في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية ، تركت معظم النزاعات بين الأعراق والأديان دون حل. في جميع دول الشرق الأوسط تقريبًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، اشتد الصراع على السلطة ، تلاه سلسلة من الانقلابات العسكرية التي انتهت بوصول القوميين العرب إلى السلطة (جمال ناصر وأنور السادات وحافظ الأسد ومعمر القذافي وجعفر نميري وصدام حسين. آخر). منذ وصول كمال أتاتورك إلى السلطة ، اتبعت تركيا سياسة تعريب الأقليات القومية (الأكراد والأرمن واليونانيين والشركس ، إلخ) في البلدان العربية – سياسة التعريب والاستيعاب القسري.
السكان الأصليون وأحد أكثر شعوب المنطقة – الأكراد ، الذين تجاوز عددهم الآن ، وفقًا للخبراء، 40 مليون شخص ، في وضع صعب للغاية. في السابق كانت مفصولة بحدود الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية، في العشرينات من القرن الماضي ، تم تقسيم الأكراد أيضًا إلى حدود ثلاث دول جديدة (تركيا والعراق وسوريا). ووصفتهم السلطات التركية بـ “أتراك الجبل” مع حظر اللغة الكردية والأخلاق والعادات، في العراق وسوريا ، نفذت السلطات المركزية عمليات ترحيل جماعية للأكراد ، وحرمتهم من الجنسية ، وقمعت الانتفاضات الكردية باستخدام الأسلحة الثقيلة ، وصولاً إلى الهجمات الكيماوية (العراق 1988).
على مر السنين، أصبحت المشكلة الكردية أكثر حدة وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا. لفتت أحداث الربيع العربي 2011 والدور الحاسم للميليشيات الكردية في العمليات البرية ضد قوى الإرهاب الدولي بشخص تنظيم الدولة الإسلامية (منظمة محظورة أنشطتها في روسيا الاتحادية) انتباه العالم مرة أخرى إلى القضية الكردية العالقة. بسبب التسامح القومي والديني ، تهرب أكراد سوريا والعراق من المشاركة في الحروب العربية والإسلامية (السنة ، الشيعة ، العلويون). لقد تبين أن الأكراد هم من طليعة القتال ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة وقاموا بحماية العالم من “الطاعون الأخضر” في القرن الحادي والعشرين. وجد الشعب الكردي نفسه في موقع الأقليات القومية في تركيا وإيران والعراق وسوريا ، ولم يتخلَّ أبدًا عن آماله في استعادة العدالة التاريخية – إنشاء دولة كردية مستقلة.
يبدو أن الأكراد العراقيين والسوريين لم يقتربوا من هذا الهدف. أصبحت كردستان العراق موضوعاً لفدرالية عراق ديمقراطي جديد ، ويحتل ممثله بحق ثاني أهم منصب في البلاد – رئيس الجمهورية العراقية. حقق أكراد العراق حقوقا وحريات متساوية مع العرب والجماعات العرقية الأخرى في البلاد. كما يبدو الوضع في كردستان سوريا أكثر تعقيدًا إلى حد ما. بعد أن ألقيتهم السلطات المركزية بالدفاع عن أنفسهم في عام 2012 ، أُجبر الأكراد السوريون على إنشاء هيئات حكم ذاتي ، ووحدات للدفاع عن النفس ، وصد هجمات عصابات داعش ، وحرروا شمال شرق البلاد بالكامل. في تحالف مع العرب والأرمن والآشوريين الذين يعيشون في شمال سوريا ، اتخذ الأكراد في البداية موقفًا محايدًا في الحرب الأهلية وأنشأوا منطقة الحكم الذاتي “روج آفا” ، وهم يحاولون الدخول في حوار مع دمشق والمعارضة حول هيكل الدولة المستقبلية لسوريا (الدستور ، الحكومة الائتلافية ، إلخ..). ضمت جماعة المعارضة الخارجية في اسطنبول العديد من الأكراد العرقيين من المجلس الوطني الكردي إلى عضويتها وحددت وجودهم في محادثات جنيف أو أستانا. يجب ألا يغيب عن الأذهان أنه في عام 1923 كان العديد من زعماء القبائل الكردية حاضرين أيضًا في مؤتمر لوزان، لكن هذا أعطى القوميين الأتراك سببًا لتبرير إدانة اتفاقيات سيفر بشأن القضية الكردية ، كما يقولون ، “لم يعترض الأكراد على حذف البنود الخاصة بإنشاء دولة كردية”.
من المحتمل أنه مع وصول المعارضة السورية المؤيدة للعقلية التركية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين (وهي منظمة محظورة أنشطتها في الاتحاد الروسي) إلى السلطة في دمشق، لن يتحسن موقف الأكراد في سوريا، بل قد يتفاقم. من غير المرجح أن يحسب الإسلام الراديكالي، مثل القومية العربية السابقة – البعثية ، مصالح الأقلية الكردية في سوريا. كما أن ما يسمى بصيغة أستانا لتسوية الصراع السوري لم تلبي آمال الأكراد أيضًا. تقريبا جميع المشاركين فيه ، باستثناء موسكو ، عارضوا بشكل قاطع مشاركة الوفود الكردية (حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي) في مفاوضات السلام. رفضت دمشق وأنقرة وطهران معًا إمكانية مشاركة الممثلين الأكراد في مناقشة مسودة الدستور المستقبلي وقضايا أخرى على جدول الأعمال.
وبالتالي، هناك محاولة أخرى، الآن من جانب المفترسين الإقليميين (إيران وتركيا) ، لإعادة إنشاء الدولة السورية دون مراعاة مصالح المنتصرين على تنظيم الدولة الإسلامية – الأقلية الكردية البالغ عددهم ثلاثة ملايين، أو لتوحيد سوريا بحكم الأمر الواقع إلى جيوب (موالية لإيران ومؤيدة لتركيا). من الواضح أن الأسد وحلفاءه الإيرانيين، فضلاً عن أردوغان ذو العقلية العدوانية، يعتمدون على القوة العسكرية لاستعادة السيطرة تدريجياً على منطقة روج آفا المتمتعة بالحكم الذاتي والاستيلاء على حقول النفط والغاز في شمال شرق سوريا. سيعتمد تنفيذ هذه الخطط ومصير الأكراد السوريين إلى حد كبير على موقف الإدارة الرئاسية الأمريكية.
وحتى الآن، تقدم فرقة أمريكية صغيرة من القوات الخاصة وطيران الجيش الدعم اللوجستي والناري للميليشيات الكردية والقبائل العربية على نهر الفرات وتعمل كضامن لسلامتهم. لكن قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قد يتغير موقف واشنطن. يعرف تاريخ الحركة القومية الكردية العديد من الأمثلة عندما تبين أن حلفاء الولايات المتحدة غير موثوقين وخانوا الأكراد، مسترشدين بمصالحهم القومية. في هذه الحالة، من المناسب التذكير بالمثل الكردي المعروف: “الأكراد ليس لديهم حلفاء موثوق بهم سوى الجبال”.
ستانيسلاف إيفانوف – دكتوراه في التاريخ، باحث أول في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خاص لوكالة أنباء “رياليست”