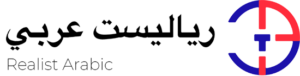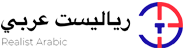لا يمكن فصل الجيش عن المجتمع رغم تباين المسؤوليات لدى الطرفين ما بين عسكرية ومدنية؛ إذ تربط المؤسسة العسكرية بالمجتمع صلات وثيقة، تنبثق عن طبيعة الجيش البنيوية والخلفيات الاجتماعية لأفراده. وبدوره، يعتبر الجيش أقوى مكونات المجتمع، بفعل الدرجة العالية التي يمتلكها من المؤسسية ووسائل القوة، والتي تمكّنه من فرض سلطته والسيطرة على باقي المكونات الإجتماعية والسياسية داخل نظام الدولة، بما فيها السلطة المدنية متى استدعت الحاجة لإعلان حالة الطوارئ والاستجابة للكوارث الكبرى التي تهدد أمن الدولة والسلامة العامة للمواطن. غير أنّه وإلى جانب هذا الدور الفاعل في وقت الشدة والأزمات، مارس الجيش على مدى السنوات الماضية دورًا فاعلًا في الإستجابة للإحتياجات الإنسانية، وبناء علاقات التعاون الإستراتيجية مع الهيئات المدنية العاملة في البيئة المحلية للدولة، والمجتمعات الخارجية حيث تنتشر قوات الدولة العسكرية.
الأزمة اليوم لم تعد صحية فحسب، بل أضحت كارثة إنسانية، إجتماعية، إقتصادية ودولية. تضع هذه الحقيقة ثقلًا أخلاقيًا على المؤسسة العسكرية، لتتحدد وفق أطره الشروط التي تبرر لجوء الجيش الى القوة ومستوى القوة المسموح استخدامها. غير أنّ المهام التي تتطلبها مسؤولية القادة والمهنيين العسكريين خلال هذه الحالة الإستثنائية لا تبدأ وتنتهي باستخدام القوة. ففي هذا الإطار، يجب أن تجمع هذه المسؤوليات بين الرؤية العامة التعاونية لإدارة الأزمة، وأن تكون في الوقت عينه مقدّمة لصنع السياسات الخلاقة والمساعدة على إحداث تغيرات جذرية يساعد المهنيون العسكريون من خلالها على درء التهديدات، بل والأهم تحويل التحديات الى فرص للتنمية المستدامة فيتحقق إثر هذا التعاون الإصلاح اللازم للنظام القائم، والضروري لنمو الوطن وتقويته.
الإطار العام التطبيقي للتعاون العسكري-المدني يختلف باختلاف مفهوم العلاقات المدنية العسكرية لدى الدول، حيث لا يوجد مفهوم حديث ثابت وموحّد لتحديده. ففي حين يعنى هذا المفهوم في الولايات المتحدة بالعمليات التعاونية التي تنشئها القيادات العسكرية الأميركية مع الوكالات المدنية في المجتمعات خارج نطاق الوطن؛ تحدِّد وكالة التعاون المدني العسكري في إيطاليا هذا الإطار التعاوني وفق ما تتطلبه مسؤولية مواجهة الظروف الطارئة بالإستناد على ما نص عليه الدستور الإيطالي أنّ “الدفاع عن الوطن واجب مقدس لجميع المواطنين“.
النموذج اللبناني في التعاون العسكري-المدني
في إطار مشابه وإنّما مغاير لذاك الذي اعتمدته إيطاليا، إتخذ لبنان لنفسه نموذج تعاون خاص ما بين المؤسسة العسكرية والمكونات المدنية للمجتمع اللبناني في الداخل؛ وقد أنشئ بداية قسم التعاون العسكري-المدني على نحو تابع لمديرية الإستعلام في أركان الجيش للعمليات عام 2012، ثم طوّره إلى مديرية التعاون العسكري-المدني عام 2014. ولليوم، نجحت المديرية بـ”تنفيذ 115 نشاط تعاون عسكري-مدني بهدف مساعدة المجتمع الأهلي والمدني وتوطيد العلاقة بين الجيش والشعب”، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: “الدعم الطبي (نهار طبي مجاني في البلدات النائية، توزيع معدات وأدوية لبعض المستوصفات، تقديم سيارات إسعاف… إلخ”.
أمّا في ضوء ناقوس الخطر الصحي، المعيشي والإقتصادي الآني في لبنان، يبدو جليًا أنه ضاقت السبل أمام الحكومة اللبنانية لإيجاد سياسة فعالة شاملة ومتكاملة، لإدارة طويلة الأمد للأزمة بمواجهة وباء كورونا. وفي واقع الأمر، كانت الأزمة الأخيرة للفيروس كما “القشة” التي قصمت ظهر البعير، بعدما سبق وأعلنت الحكومة عجزها عن الخلاص من العجز العام للدولة والوفاء بمستحقاتها الدولية، فكيف الحال بالقدرة على بناء الدولة.
وإذ يتّضح وجود معارضة لإعلان حالة الطوارئ بمواجهة أزمة كورونا، لدى فئة كبرى من الشعب اللبناني، على اعتبار أنّ الأزمة الراهنة تعبّر عن حالة غير عسكرية رغم دقّتها من حيث تهديد الأمن الصحي، يرى هؤلاء أنّ القواعد التي ترعى حالة الطوارئ تعطي صلاحيات واسعة للقوى العسكرية على نحو لا يتناسب مع الوضع القائم، بحيث تكون هذه السلطة العسكرية مبررة فقط في حالة الحرب. ومن أبرز هذه الصلاحيات، وضع كل القوى المسلحة بإمرة قائد الجيش؛ فرض الرقابة على مصادر الطاقة والمواد الأولية والتموينية وتنظيمها، كما والرقابة على النقل والإتصالات والمواصلات، وحتى مصادرة الأموال والأشخاص.
وعلى الرغم من هذا الإحتجاج، إلا أننا نلحظ قانونيًا مشروعية إعلان حالة الطوارئ تبعًا لخطورة الأزمة التي تأخذ طابع الكارثة كوباء عالمي؛ بحيث يؤكد نص المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52، أنه “تعلن حالة الطوارىء أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية أو في جزء منها عند تعرض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة”. وعليه، فإنّه لو عادت وارتأت الحكومة اللبنانية وجوب إعلان حالة الطوارئ، أمكنها ذلك شرعًا، على أن يتم ذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي المذكور، والتي نصت على أن تعلن حالة الطوارىء، أو المنطقة العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بأكثرية الثلثين، وأن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام، وإن لم يكن في دور انعقاد.
لم تعلن الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ وإنما بادرت لإعلان”التعبئة العامة”، وذلك بموجب القرار رقم 1 الصادر بتاريخ 15/3/2020 عن مجلس الوزراء مجتمعًا؛ وهو قرار إداري نافذ وملزم لمهلة حددت بشكل مبدئي من يوم 15 مارس حتى ليل 29 مارس، لتعود وتمدّد المهلة لغاية 12 أبريل. ويستند هذا القرار من حيث القانون الى المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني والتي تفيد بإمكانية إعلان حالة التعبئة الكلية أو الجزئية، وكذلك حالة التأهب الكلي أو الجزئي، “إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر”، بحيث يستتبع هذا القرار رفع جهوزية الدولة وإتخاذ تدابير متدرجة على النحو الذي تتطلبه مواجهة الأخطار ودرءها. وقد نجحت الحكومة اللبنانية بالفعل في إدارة الأزمة بفعل هذه التدابير الأمنية – رغم التحفظات المتعلقة بالأمن المصرفي والإقتصادي وغياب الرعاية المعيشية والخدماتية – بحيث حدّت بشكل كبير من سرعة إنتشار الفيروس لما كانت لاقت إستجابة وإلتزام من المواطنين بالحجر المنزلي.
في تقييم لسياسة التعبئة العامة ونتائجها، نلحظ جدوى التدابير المتخذة من قبل الحكومة في الإطار الأمني، وإن أتت متأخرة من حيث التقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس في أولى مراحله. أمّا وبعد أيّام من تصريح وزير الصحة اللبناني عن خروج لبنان من مرحلة إحتواء الفيروس، قررت الحكومة بناء على إنهاء مجلس الدفاع الوطني إعلان “التعبئة العامة” المستندة إلى التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 من قانون الدفاع الوطني. وإذ تعنى التعبئة العامة بإتخاذ “تدابير لازمة عند التعرض للخطر”، تقرّر الإستمرار بقرار منع التجمعات الذي كانت قد بادرت إليه الحكومة مع بداية الأزمة من خلال الأمر بإقفال المؤسسات التعليمية على مراحلها، وإقفال مراكز الترفيه وأماكن التجمعات العامة. وقد تدرجت هذه التدابير مع قرار التعبئة نحو إغلاق الحدود اللبنانية، ثم تعليق حركة الطيران في مطار بيروت الدولي، لتعود وتفرض الحجر المنزلي للمواطنين مع عدم التنقل الا للضرورة القصوى، وقد ألزمت المؤسسات كافة ما عدا الغذائية والصحية منها بالإقفال التام وحظر التجول بين الساعة السابعة مساءًا والخامسة صباحًا تحت طائلة المسؤولية. وحيث يقتضى الإعتراف بمساهمة هذه التدابير في الحد من إنتشار الفيروس بشكل فعّال؛ فلا بد من التنويه أيضًا بصوابية القرار بإخلاء السبيل لعدد من السجناء تفاديًا لكارثة تفشي عدوى الفيروس في السجون المكتظة؛ كما والإشادة بالجهود الوزارية المبذولة لتطوير المنهج التعليمي إلى نظام التعليم عن بعد، والسرعة في إنشاء منصّة رقمية لإدارة السياسة التعليمية وإيجاد الوسائل البديلة التي من شأنها أن تكفل حق الطلاب في التعلّم.
في تصريح أخير، أشار رئيس مجلس الوزراء أنّ “ما يجري حاليا هو حال طوارئ في إطار التعبئة العامة”، فيما أكّد إستبعاد أن تلجأ الحكومة لإعلان حالة الطوارئ باعتباره أنّ “حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها صعبة ولا يمكن تطبيقها في لبنان”. وفي حقيقة الأمر، يجيز البند 3 من المادة 2 المنظّمة لحالة التعبئة العامة، إمكانية أن تتضمن المراسيم أحكاما خاصة متماثلة بالفعل مع تلك المقررة في حالة الطوارئ، وهي الهادفة إلى: “أ) فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها؛ ب) فرض الرقابة على المواد الأولية والإنتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها خزنها، تصديرها وتوزيعها؛ ج) تنظيم ومراقبة النقل والإنتقال والمواصلات والإتصالات؛ د) مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين”.
وعلى ما تقدّم، يمكن لنا النظر بشكل جدّي في أفضلية الإبقاء على حالة “التعبئة العامة” مع إقرار ما يلزم من التدابير الإضافية بموجب أحكام خاصة، تحدّد وفق الأهمية التي كان يُرتأى لأجلها وجوب إعلان حالة الطوارئ. وبهذه الحالة للحكومة أن تتشدّد في التدابير المتخذة حاليًا في الحد من حرية التنقل والتظاهر والتجمع، وأن يعاز إلى القوى العسكرية والأمنية إتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق القرارات المعنية بالإقفال العام، حظر التجول، الحجر المنزلي أو حتى الإقامة الجبرية وغيرها ممّا تستدعيه خطورة الأوضاع، دون حاجة فعلية لإعلان حالة الطوارئ من باب الحرص على “مدنية” الحكم في السلطة وديمقراطيته. غير أنّ التغلب على تهديدات هذه المرحلة الإستثنائية ومعالجة آثارها، يتطلب في واقع الأمر “إدارة إستثنائية شمولية للأزمة” فيما يتعدّى التطبيقات الآلية الآنية لحالة التعبئة العامة، ويتجاوز محدودية دور القوى العسكرية بضبط الأمن.
لنا أن نوصّف دور الجيش اللبناني الراهن في حالة “التعبئة العامة”، بأنّه دورٌ وقائي، رقابي، توعوي، معوني، وإجرائي أمني. ففي إطار تنفيذ الخطة الرامية إلى تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بمنع التجمعات وإقفال المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة، تحركت وحدات الجيش للإنتشار بشكل فوري فوق الأراضي اللبنانية، وقد عملت على فك التجمعات وإقفال الطرقات والحدود اللبنانية وما تشمل من المعابر غير الشرعية. وتوجّهت قيادة الجيش إلى المواطنين بالدعوة للبقاء في منازلهم حفاظا على سلامتهم، وعدم المغادرة إلّا للضرورة القصوى، محذّرة من عدم التجمع تحت طائلة المسؤولية، بحيث تشكل مخالفة القرار جرمًا تبعًا لنص المادة 770 من قانون العقوبات؛ وقد لجأت قوى الجيش في هذا الإطار إلى النداء للإلتزام بالحجر عبر مكبرات الصوت أثناء تسيير الدوريات وتجوال طوافات الجيش فوق العاصمة بيروت وباقي المناطق. وفي سياق آخر، بادرت قيادة الجيش إلى إطلاق حملات توعية مكثفة عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي حول سبل الحماية الواجبة للوقاية من الفيروس؛ وقد حرصت على إبقاء المواطنين على إطلاع بالتدابير المتخذة والإجراءات المتبعة، مع التزام الشفافية من حيث دحض الأخبار الزائفة وتصويبها. ولمّا كانت بدأت وحدات الجيش بتصنيع كمامات صحية، تسلّمت مديرية التعاون العسكري-المدني في الجيش اللبناني كمامات وقفازات طبية كهبة من وحدة التعاون العسكري-المدني في السفارة الأميركية، وقامت بتوزيعها على العسكريين؛ كما بادرت المديرية إلى تقديم المعونات الغذائية للعائلات المحتاجة، معلنة شعار “نحن بجانبكم في كل الظروف”.
على الرغم من الدور الجليّ الذي تقوم به مديرية التعاون العسكري-المدني في الجيش اللبناني في ضوء الظروف الراهنة من توزيع الحصص الغذائية على الأهالي وتأمين اللوازم الطبية للعسكريين، إلّا أنّه لا بدّ لنا من الدعوة إلى أهمية تفعيل دور مديرية التعاون العسكري-المدني في مواجهة الأزمة، على النحو الذي تمارس به المديرية مهامها المعنيّة بـ”عمليات الطوارئ المدنية” المنصوص عليها في البند السادس من مهام الأقسام الإقليمية التابعة للمديرية. بموجب هذا البند، يكون على المديرية المشاركة في التخطيط مع الأجهزة الحكومية والسلطات المحلية والهيئات الأهلية لعمليات الطوارىء المدنية، إن في حالات الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، في الأزمات وفي العمليات الإرهابية، بهدف الإستجابة السريعة لمواجهة الأزمة والتقليل من آثارها. حتى وأنّ المواد المنظّمة لمهام المديرية في الحالات الطبيعية، تظهر أهميّة الدور الذي يمكن أن يكرّسه التعاون العسكري-المدني ليس فقط في مواجهة الكارثة الوبائية الحالية، بل وفي معالجة الأزمة الإقتصادية التي كانت قد ألمّت بلبنان بُعَيد إنتشار الفيروس، بحيث تساهم بشكل فعلي في تجنّب إنهيار حتميّ للنظام الإقتصادي. في هذا السبيل، يكون للحكومة، بناءًا على قانون الدفاع الوطني رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/1983، وبموجب مرسوم وزاري مبني على إقتراح وزير الدفاع الوطني والوزير المختص، إستخدام قوى الجيش في الحقول الإنمائية والإجتماعية، حيث تستدعي المصلحة الوطنية تعاونهم، على أن لا يعيق ذلك مهمات الجيش الأساسية.
وتُعزّز الهيكلية الإدارية لمديرية التعاون العسكري-المدني في الجيش اللبناني من الكفاءة في أداءها الوظيفي، بحيث تكفل الأقسام الإقليمية التابعة للمديرية في كل من الشمال، البقاع والجنوب اللبناني، إلى جانب النطاق الإقليمي لعمل المديرية، الوصول إلى كافة المناطق اللبنانية على النحو الذي يمكّنها من دراسة المحيط المدني الإجتماعي، الحياتي والإنمائي لمختلف المناطق. وإنّه بناء على تقييم مديرية التعاون العسكري-المدني لهذه الدراسات، تتوسّع مهام الأقسام الإقليمية في تحديد الحاجات الحياتية والإنمائية للمحيط المدني؛ إقتراح، تخطيط وتنفيذ المشاريع الإجتماعية، الحياتية والإنمائية؛ بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع القوى العسكرية الأجنبية المتواجدة في المنطقة تحت راية الأمم المتحدة على تحديد المشاريع وتنفيذها. وبدورها، تنسّق المديرية مع المنظمات والهيئات المانحة، العسكرية منها والمدنية الراغبة بتمويل المشاريع؛ وهو ما من شأنه أن يضاعف الفرص لنيل التمويل الخارجي عبر المديرية، نظرًا لصعوبة إستحصال الحكومة للدعم المالي الدولي آنيًا.
في ضوء ما سبق، وحيث تستدعي إدارة الأزمة الراهنة حماية المواطن من كافة المخاطر المحدقة به، فإننا ندعو الحكومة اللبنانية إلى بناء استراتيجية إنقاذية شاملة، تؤمّن التكامل الوظيفي للعمليات العسكرية والمدنية وتعمل على تفعيل السياسات التعاونية ما بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، على النحو الذي تتحقق به الإدارة الفعالة للأزمة ومعالجة آثارها، وإغتنام الفرص التي تجعل من الوضع الراهن بيئة ملائمة لإعادة بناء الوطن.لارا الذيب- باحثة قانونية إستراتيجية، خاص لوكالة أنباء “رياليست”