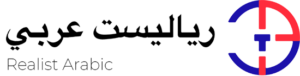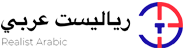القاهرة – (رياليست عربي): إن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية وتأثيراتها على وسائل الإعلام والاتصال الحديثة وعلوم الفضاء المتطورة يومًا بعد يوم تشكل حاليًا عاملًا حاسمًا في قيادة التوجهات العالمية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع الدول الكُبرى إلى الاستثمار في هذا القطاع إلى حد الجنون لإدراكها بأهميته في إستراتيجيات السيطرة على الدول النامية التي تفتقر إلى التكنولوجيا المعلوماتية والعلمية بشكل عام. فالتكنولوجيا باتت تفرض تحديات لا يمكن لأية دولة تجاهلها أو التغاضي عنها بأي شكل من الأشكال، ولابد من التعامل معها وفق رؤية مستقبلية واضحة تُترجم إلى خطط بعيدة المدى على أكثر من صعيد.
ويجتمع الإعلام وعلوم الفضاء في عالم افتراضي يربط الإنسان بالعالم الخارجي، فمع التطور التكنولوجي المستمر، أصبح الإعلام المقروء والمسموع والمرئي يستخدم شبكة المعلومات الدولية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الأحداث والمعلومات والمعارف المختلفة إلى الجمهور، وهي نفسها الشبكات التي تستعين بها علوم الفضاء لخلق حلقة وصل بين الإنسان والكون. ومن هنا تبرز أهمية العالم الافتراضي في ربط الإنسان بالعالم الخارجي معرفيًا وعلميًا.
وقد شهد الإعلام خلال العقود الأخيرة تطورًا كبيرًا على المستوى التقني، فلم يعد يعتمد على الصحف المطبوعة وأجهزة الراديو والتليفزيون في توصيل المعلومات، بل أصبح هناك إعلام آخر يعتمد على شبكة الإنترنت يُعرف بأسماء عديدة يأتي في مقدمتها “الإعلام الجديد” والمقصود به “الإعلام الإلكتروني”، و”الإعلام الرقمي”.
أما عن علوم الفضاء فهي تهتم في المقام الأول باستكشاف الفضاء ودراسة الظواهر الكونية، وتنقسم إلى 7 علوم فرعية: الفيزياء الفلكية، وعلم المجرة، وعلم النجوم، وعلم الكواكب، وعلم الأحياء الفلكية، وريادة الفضاء، والرحلة الفضائية. وجميع هذه العلوم تعتمد في بحوثها ودراساتها على تكنولوجيا الاتصال عن بُعد المتمثلة في إطلاق الأقمار الصناعية وإرسال البعثات إلى الفضاء الخارجي، وبالتالي تصبح شبكة الإنترنت هي حلقة الوصل بين الأرض والفضاء.

وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في الإعلام وعلوم الفضاء سيشهد كل منهما طفرةً كبيرةً على المستوى التقني، خاصة مع بزوغ عالم مواز يجسد عالمنا الواقعي بشكل افتراضي يعرف باسم “الميتافيرس”، فبالنسبة للإعلام سيختفي نهائيًا الإعلام التقليدي، ويحل محله إعلام رقمي سيتحول بدوره إلى إعلام افتراضي أو بالأحرى “إعلام ميتافيرسي”، ولعل القرار الذي اتخذته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) بغلق عدد من محطاتها الإذاعية الناطقة باللغات الأجنبية من بينها إذاعة بي بي سي العربية خطوة مبدئية على هذا الطريق، وبالتالي سيتحول الإعلام بأشكاله كافة إلى مجموعة من التطبيقات المحملة على الحواسيب والهواتف النقالة تتيح للإنسان الاطلاع على الأخبار والمعلومات في أي زمان ومكان.
وإذا أتينا إلى علوم الفضاء سنجد أنها تقوم منذ نشأتها على شبكة اتصالات متطورة ترتبط بشكل أو بآخر بشبكة الإنترنت، وبالتالي كلما تطورت وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، سينعكس ذلك على تطور علوم الفضاء ومجال دراساتها بما في ذلك الاكتشافات الفضائية التي تتم عن طريق المِرصد الأرضي “التلسكوب”، أو المركبات الفضائية الآلية ورحلات الفضاء البشرية.
وتتضمن هذه الدراسة النقاط التالية:
- أولًا: التعريف بالإعلام
- ثانيًا: الأعلام القديم “التقليدي” والإعلام الجديد “الإلكتروني”
- ثالثًا: الفرق بين الإعلام القديم والإعلام الجديد
- رابعًا: التعريف بعلوم الفضاء
- خامسًا: مجالات علوم الفضاء
- سادسًا: الأقمار الصناعية وأهميتها
- سابعًا: مستقبل الإعلام وعلوم الفضاء
- Ø تمهيد: الميتافيرس واستخداماته
- Ø مستقبل الإعلام في عصر الميتافيرس
- Ø مستقبل علوم الفضاء “استيطان الفضاء”
- ثامنًا: عراقيل تطور الإعلام وعلوم الفضاء في العالم العربي
- تاسعًا: مصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- عاشرًا: النتائج والتوصيات
أولًا: التعريف بالإعلام
إن مصطلح “إعلام” يعني “الإخبار” و”تقديم المعلومات” حتى يعلمها الجميع، وتنطوي عملية الإخبار على “رسالة إعلامية” تتمثل في أخبار، أو معلومات، أو أفكار، أو آراء، أو رؤى، أو توجهات تنتقل من مرسل (الطرف المُعلِم) إلى مستقبل (الطرف المتلقي). وكلمة إعلام في اللغة تعني التبليغ والإبلاغ أي الإيصال، فيُقال بلغتُ القوم بلاغًا، أي أوصلتُ لهم الشيء المطلوب، والبلاغ ما بلغكَ أي وصلكَ من أمر، فنقول في الاصطلاح الشعبي: “الحاضر يعلم (يبلغ) الغائب”.

أما عن تعريف الإعلام بمعناه المتداول، فيقصد به التعريف بقضايا العصر ومشاكله وكيفية معالجة هذه القضايا من خلال الوسائل الإعلامية الداخلية والخارجية، إلا أن العالم الألماني “أوتو جروت” Otto Grote يعرف الإعلام بأنه “التعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير وروحها وميولها واتجاهاتها”، في حين يعرفه الكاتب الفرنسي “ألبير كامو” Albert Camus قائلًا: “إن الإعلام النزيه والحيادي والصادق له دور مهم في نشر الوعي بين الناس، لذا فوسائل الإعلام مُلزمة بمراقبة ما تبثه إلى العقول، وعند نقلها الأخبار والمعارف والثقافات، تتخذ هدفًا نبيلًا تجعله يبتعد عما يُسيء له ولمن حوله “.
وقد يقوم الإعلام بتزويد الناس بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة والحقائق الواضحة، ويهدف بذلك تنوير الناس وتثقيفهم ونشر الوعي بينهم. وقد يقوم أيضًا بتزويد الناس بأكبر قدر ممكن من الأكاذيب، ويزيف الحقائق، ويهدف بذلك خداع الناس وضلالهم والتلاعب بمشاعرهم كي يثير بينهم الفتنة والفرقة، وبالتالي يخدم هذا النوع من الإعلام أعداء الأمة، وينفذ مخططاتهم سواء كان موجهًا من الداخل أو الخارج.
لذا فإن التعريف العلمي الصحيح للإعلام ينبغي أن يشمل النوعين السابقين، أي الإعلام الصادق الخيّر المنير، والإعلام الكاذب الشرير المضلل، وبناءً على ذلك يُعرف الإعلام بمعناه الشامل بأنه “نقل الأخبار والمعلومات والمعارف والثقافات والأفكار والآراء والرؤى والتوجهات بصورة موجهة أو غير موجهة من خلال الوسائل الإعلامية المادية أو المعنوية ذات الصفة الحقيقية “الطبيعية” أو الاعتبارية، بهدف التأثير الإيجابي أو السلبي على عقول الجماهير المختلفة في أي مكان وزمان”.

ثانيًا: الإعلام القديم “التقليدي” والإعلام الجديد “الإلكتروني”
الإعلام القديم “التقليدي”
يُقصد بالإعلام القديم الإعلام الذي يُبث عبر الوسائل الإعلامية التقليدية “الصحف والمجلات المطبوعة، وأجهزة الراديو والتليفزيون”، وقد تكون هذه الوسائل ملك الدولة، أو ملك الأفراد أو الجمعيات أو الأحزاب أو المؤسسات الخاصة. وتختلف النُظم الإعلامية باختلاف الأنظمة السياسية في كل دولة، حيث تعكس الوسائل الإعلامية النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولتها، وكذلك نوع العلاقة بين الشعب والحكومة. والإعلام التقليدي إعلام يسهل السيطرة عليه من قبل الدولة أو المؤسسات الخاصة على عكس الإعلام الجديد كما سنرى خلال السطور القادمة.

- الإعلام الجديد “الإلكتروني”
يُقصد بالإعلام الجديد الإعلام الذي يعتمد على شبكة المعلومات الدولية، ويُبث عبر الوسائل الإلكترونية المتعددة على شبكة الإنترنت، لذا عرف بـ “الإعلام الإلكتروني”، وكذلك “الإعلام الرقمي”. ونظرًا لأن الإعلام الجديد يستخدم الإنترنت كوسيلة أساسية له، فقد استطاع أن يستوعب تحت عباءته سائر الوسائل الإعلامية التقليدية الأخرى المقروءة والمسموعة والمرئية، وحولها إلى وسائل رقمية.
وتتعدد وسائل الإعلام الجديد، حيث تشمل: “الصحف والإذاعات والقنوات التليفزيونية الإلكترونية، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وإنستجرام، وتليجرام، وتيك توك)، والمدونات الإلكترونية على الإنترنت”.

والإعلام الإلكتروني شأنه شأن الإعلام التقليدي قد يكون ملك الدولة، أو ملك الأفراد أو الجمعيات أو الأحزاب أو المؤسسات الخاصة، لكن بالإضافة إلى الدولة والأفراد والمؤسسات، أصبح الجمهور أيضًا يمتلك وسائل الإعلام الإلكتروني، فأي شخص في أي مكان وزمان بات يستطيع أن ينشئ صفحةً له على فيسبوك أو تويتر، أو يطلق قناةً له على يوتيوب أو تليجرام، وينشر بها ما يشاء من أخبار ومعلومات وآراء دون قيد أو شرط، وهو ما يجعل الإعلام الإلكتروني خاصة وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع للرقابة من قبل أحد، وتتمتع بقدر لا محدود من الحرية قد يستغلها المغرضون في الداخل أو الخارج ضد مصالح الدولة العُليا وأمنها القومي، ولعل الثورات العربية خير مثال على هذا الأمر.

ثالثًا: الفرق بين الإعلام القديم والإعلام الجديد
مما لا شك فيه أن هناك فروق عديدة بين الإعلام القديم والإعلام الجديد، كما أنهما يتوافقان حينًا ويتنافران حينًا آخر، فالإعلام الإلكتروني إعلام ديناميكي تفاعلي يجمع بين النص والصوت والصورة في آن واحد، وذلك على عكس الإعلام التقليدي غير التفاعلي – المرسل فقط – المقتصر على النص والصورة الثابتة في الصحف، أو الصوت في الراديو، أو الصوت والصورة المتحركة في التليفزيون.
ومن أبرز خصائص الإعلام الإلكتروني:
- إنه إعلام تفاعلي بين المصدر والمتلقي، حيث يتيح هذا الشكل الإعلامي للمتلقي فرصة التعليق والنقد.
- يتحول المتلقي في الإعلام الإلكتروني إلى ناشر يستطيع أن ينشر ما يريد.
- يسهل استخدامه، فهو متاح للجميع، وفي متناول أيديهم من خلال الحواسيب والهواتف النقالة.
- متعدد الوسائط يستعين بالكلمة والصوت والصور والمقاطع المصورة في آن واحد.
- يستطيع الإعلام الإلكتروني أن يندمج مع الإعلام التقليدي، وأحيانًا يستوعب الشكل الثاني في قوالبه.

وتعد “الحرية الفردية” هي الفرق الجوهري بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، فقد تحول كل شخص في أي زمان ومكان عبر وسائل الإعلام الجديد إلى رئيس تحرير ورئيس قناة ينشر ما يريد نشره، لذا تعد قضية عدم التدقيق وعدم الثقة في صحة المواد المنشورة من أبرز مساوئ الإعلام الجديد.
والإعلام الإلكتروني باعتباره قائمًا على اللامركزية في استقاء الأخبار والمعلومات ونشرهما فقد ألقى بظلاله على الإعلام التقليدي، وأحدث تغييرًا كبيرًا داخل عملية الاتصال بين المرسل والمستقبل، وزاد من حرية التعبير لدي الجمهور وحجم مشاركته في صنع الحدث الإعلامي من خلال التغطية المباشرة للأحداث أو الإدلاء بالرأي في التعليقات.
ونظرًا لاستيعاب الإعلام الإلكتروني للإعلام التقليدي، حدث تراجع كبير لوسائل الإعلام التقليدية، وانحسر عدد مستخدميها ومتابعيها بشكل كبير، ومع ذلك يواجه الإعلام الإلكتروني بعض الإشكاليات في انتشاره، ومنها:
- صعوبة الوثوق في المحتوى الإعلامي المقدم والتحقق من صحته ومصداقيته.
- ضعف الضوابط الضامنة عدم المساس بالقيم الدينية والعقائدية والأخلاقية والثقافية للمجتمعات المختلفة.
- ضعف السيطرة على نشر المواد المتضمنة عنف، أو جنس، أو تطرف، أو إرهاب.
- انتهاك الملكية الفكرية وحقوق النشر.
- ارتكاب الجرائم الإلكترونية وانتشارها على نطاق واسع بسبب استخدام التقنيات الحديثة.
- صعوبة الحفاظ على أمن الوثائق والبيانات والمعلومات في ظل التطور التقني المتسارع المُعَرَّض إلى الاختراق بصورة مستمرة.

ومن الممكن حصر الفروق الرئيسة بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني فيما يلي:
- الإعلام الإلكتروني إعلام حر خال من القيود والرقابة على عكس الإعلام التقليدي، حيث يستطيع الجميع في الإعلام الإلكتروني أن ينشروا أفكارهم، ويعبروا عن آرائهم بحرية مطلقة.
- أصبح الإعلام التقليدي في وقتنا الحالي يعتمد بدرجة أكبر على الإعلام الإلكتروني بسبب صعوبة الوصول إلى أماكن الأحداث، ونقاط التوتر حول العالم، حيث يعد أكثر أمانًا للصحفيين والعاملين في قطاعات الإعلام المختلفة.
- ظهر نوع جديد من الإعلاميين يمكن تسميتهم بـ “الإعلاميين الجُدد” نسبة إلى الإعلام الجديد، وهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أو من يطلق عليهم “نشطاء السوشيال ميديا” من خلال تغطيتهم مجريات الأحداث وبؤر التوتر حول العالم. وعلى الرغم مما يشوب هذه التغطيات الإعلامية من عيوب إلا أنها يمكن أن تتحسن في القريب العاجل مع العمل المتواصل.
- يشهد الإعلام الإلكتروني نشاطًا اقتصاديًا واسعًا وطفرةً نوعيةً غير مسبوقة مع تنافس الجميع على الحصول على السبق الخبري “الترند”.
- يوفر الإعلام التقليدي أرضيةً خصبةً للإعلام الإلكتروني عن طريق التسويق، فلولا دعم الشكل الأول للشكل الثاني لما ظهر الإعلام الإلكتروني إلى العلن، وانتشر على هذا النطاق الواسع.
- ساهمت الطفرة النوعية في أعداد مستخدمي الإنترنت أو المتصفحين اليوميين في توفير أرضية خصبة للإعلام الإلكتروني.
- إن الإعلام الإلكتروني تطور طبيعي للإعلام التقليدي، حيث إن المواقع الإعلامية الإلكترونية قد انطلقت منذ عدة عقود عندما بدأت الصحف الأمريكية في إطلاق مواقعها الإلكترونية في الثمانينيات من القرن الماضي، وبدأت الخدمات التفاعلية مثل “نيويورك تايمز” The New York Times، و”يو إس إيه توداي” USA Today، وغيرهما من الصحف العالمية الشهيرة حاليًا.
- العلاقة بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني علاقة تكاملية يعتمد فيها كل منهما على الآخر، حيث إن صناعة الأخبار والمعلومات تبدأ من وسائل الإعلام التقليدي، ولكن يختلف كل منهما في شكل تداول هذه الأخبار والمعلومات.
- الأخبار والمعلومات المنقولة عبر الإعلام الإلكتروني أسرع انتشارًا وتداولًا من انتقالها عبر الإعلام التقليدي، لأنها تتخطي حاجز الحدود الزمنية والمكانية اعتمادًا على الإنترنت.
- 10. أصبحت معظم وسائل الإعلام التقليدية (الصحف، والإذاعة، والتليفزيون) تعتمد بشكل أساسي على مواقعها الإلكترونية في مواكبة السرعة والانتشار والتفاعلية مع المجتمع.
- 11. يجب التفريق العلمي بين وسائل الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فكلاهما له أدواته ومميزاته عن الآخر، فصناعة الإعلام الإلكتروني لها مدخلات، وتعتمد على تنظيم مؤسسي، بينما وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، وتويتر، والمدونات الإلكترونية لا تخضع لأية ضوابط أو تنظيم يدعم الثقة في استقاء الأخبار والمعلومات المتداولة بها، ويجعلها عرضة للعديد من التجاوزات الفردية.
- 12. الإعلام التقليدي يمر بمراحل تطور مستمرة ومرونة تسمح بإمكانية تفاعله مع الجمهور ليكون ضمن منظومة الإعلام الجديد، لكن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تتطور لتصبح أكثر تنظيمًا وانضباطًا وتكون ضمن منظومة إعلامية متكاملة.
- 13. عدم خضوع الإعلام الإلكتروني لضوابط يعطيه الميزة التي يفتقدها الإعلام التقليدي، وهي “حرية التعبير المطلقة”، و”المشاركة الفعالة” في صنع الأخبار والأحداث وتداول المعلومات، وهو ما أحدث فرقًا شاسعًا بين أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام التقليدية حتى إن كانت إلكترونية.
- 14. هيأ الإعلام الإلكتروني فرصةً غير مسبوقة لأشخاص من الجمهور للمشاركة فيه، وأثبت أنهم يمتلكون قدرةً كبيرةً على خوض التجربة الإعلامية بعيدًا عن الضغوط الروتينية التي تتصف بها وسائل الإعلام التقليدية.
- 15. مبدأ التكلفة هو هدف اقتصادي لا يمكن إغفاله في صناعة الإعلام التقليدي، لكن الإعلام الإلكتروني يتيح لملايين الناس المشاركة المجانية في صناعة المحتوى الإعلامي عن طريق التعامل مع فضاء إلكتروني واسع المدى على عكس الإعلام التقليدي المقيد ماديًا ومعنويًا.
- 16. الرقابة الدائمة في الإعلام العربي سبب رئيس في نفور الجمهور من وسائل الإعلام التقليدية ولجوئه إلى وسائل الإعلام الإلكترونية، مما أعطى للشكل الثاني خاصة وسائل التواصل الاجتماعي السبق الخبري بصفة مستمرة.
- 17. أتاحت وسائل الإعلام الإلكترونية مجالًا لخلق مزيج من ثقافات متباينة قد تكون سلبية أحيانًا، ولكنها تفرض نفسها على واقع الإعلام التقليدي.
- 18. تتميز وسائل الإعلام الإلكترونية عن التقليدية بالطبيعة الديناميكية للمحتوى أي علاقتها التفاعلية مع المتلقي، وتشير الإحصائيات إلى الفجوة الكبيرة بين أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام التقليدية.
رابعًا: التعريف بعلوم الفضاء
تُعرف علوم الفضاء باسم “علم الفلك”، وهي تشمل جميع التخصصات العلمية الخاصة باستكشاف الفضاء ودراسة الظواهر الكونية والأجسام المادية في الفضاء الخارجي. وهناك 7 تصنيفات مستقلة تندرج تحتها علوم الفضاء؛ وهي: الفيزياء الفلكية، وعلم المجرة، وعلم النجوم، وعلم الكواكب، وعلم الأحياء الفلكية، وريادة الفضاء، والرحلة الفضائية.

خامسًا: مجالات علوم الفضاء
- الفيزياء الفلكية: وتدرس طبيعة الأجسام الفلكية ومواقعها وحركتها في الفضاء كالشمس، والمجرات، والكواكب، والنجوم، والوسط بين النجوم، وإشعاع الخلفية الكونية الميكروي، بالإضافة إلى ما تصدره هذه الأجسام من إشعاعات عبر الطيف الكهرومغناطيسي. كما تدرس الفيزياء الفلكية سائر خصائص هذه الأجسام كالسطوع، والكثافة، والحرارة، والتركيب الكيميائي، وغيرها.
- علم المجرة: ويدرس مجرة درب التبانة بما تضمه المجموعة الشمسية من نجوم وكواكب وأقمار وغيرها من أجسام في هذه المجرة.
- علم النجوم: ويدرس النجوم الفلكية، وهي أجسام كروية تتكون من البلازما. ويستمد النجم لمعانه من الطاقة النووية المتولدة داخله، حيث تلتحم ذرات الهيدروجين مع بعضها بعضًا مكونة عناصر أثقل منها مِثل الهيليوم والليثيوم وسائر العناصر الخفيفة حتى عنصر الحديد. ويُسمى هذا التفاعل الفيزيائي اندماجًا نوويًا تنتج عنه طاقة حرارية مهولة تصل إلينا في صورة أشعة ضوئية. والشمس هي أقرب نجم لكوكب الأرض، وتعد مصدر الطاقة للكوكب.
- علم الكواكب: ويُعرف أيضًا باسم “علم الفلك الكوكبي”، وهو يدرس الكواكب والأقمار وأنظمتها وعملية تكونها. وعلم الكواكب مجال متعدد التخصصات، ونشأ في الأصل من علمي الفلك والأرض، لكنه يجمع بين فروع كثيرة من المعرفة تشمل علم الفلك الكوكبي وجيولوجيا الكواكب المتضمنة علوم الجيوفيزياء، والجيوكيمياء، والجغرافيا الفيزيائية، وعلوم تشكيل الأرض والغلاف الجوي، وعلوم الكواكب النظرية داخل المجموعة الشمسية وخارجها. وهناك كذلك تخصصات أخرى مثل فيزياء الفضاء التي تهتم بدراسة تأثير الشمس على كواكب المجموعة الشمسية.

- علم الأحياء الفلكية: وهو حقل علمي متعدد التخصصات يهتم بأصل الكون وتطوره وتوزيعه ومستقبل الحياة فيه. كما يدرس هذا العلم إمكانية الحياة خارج كوكب الأرض. ويستعين علم الأحياء الفلكية بعلوم الأحياء الجزيئية والفيزياء الحيوية والكيمياء الحيوية والكمياء والجيولوجيا، وعلوم الفلك والكون الفيزيائي والكواكب خارج المجموعة الشمسية من أجل التحقق من إمكانية الحياة على كواكب أخرى غير الأرض، والتعرف على المحيطات الحيوية خارج الأرض.
- ريادة الفضاء: والمقصود بها تدريب الأشخاص في برامج خاصة حتى يُهيئوا لقيادة المكوك الفضائي والقيام برحلة فضائية. وكان تدريب رواد الفضاء حتى عام 2002 مقصورًا على الحكومات فحسب، إما بواسطة الجيش أو وكالات الفضاء المدنية. وبعد الرحلة التي قامت بها “سفينة الفضاء الأولى” SpaceShipOne في عام 2004 الممولة من القطاع الخاص، ظهرت فئة جديدة من رواد الفضاء تُعرف باسم “رواد الفضاء التجاريين” أو “سُيّاح الفضاء”.
- الرحلة الفضائية “السفر إلى الفضاء”: وهي رحلة إلى الفضاء الخارجي، ويوجد منها نوعان؛ “الرحلة المأهولة” و”الرحلة غير المأهولة”. وكان “يوري جاجارين” Yuri Gagarin أول رائد فضاء سوفيتي يقوم برحلة فضائية عام 1921 على متن المركبة الفضائية “فوستوك-1” Boctok-1. وتتضمن الأمثلة على الرحلات الفضائية المأهولة برنامج “أبولو” الأمريكي للهبوط على القمر، وبرامج رحلات المكوك الفضائي، وبرنامج “سايوز” الروسي لرحلات الفضاء، بالإضافة إلى محطة الفضاء الدولية حاليًا. أما الرحلات الفضائية غير المأهولة فتتضمن المسابر الفضائية التي تغادر مدار الأرض، وكذلك الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض مثل أقمار الاتصالات. وتُستخدم الرحلات الفضائية في العديد من المجالات، من أبرزها: الاستكشافات الفضائية، والنشاطات التجارية مثل السياحة الفضائية، والأقمار الصناعية المستخدمة في مجالات الاتصالات، والاستطلاع والتجسس، ورصد كوكب الأرض والفضاء.
سادسًا: الأقمار الصناعية وأهميتها
تعتمد علوم الفضاء على الرحلات الفضائية والأقمار الصناعية بصفة عامة كونها قاعدةً أساسيةً لتطور هذه العلوم ووصولها إلى نتائج ملموسة، فلولا إطلاق تلك الرحلات والأقمار إلى الفضاء الخارجي لما تمكنت البشرية من اكتشاف الفلك وسبر أغواره.

وتدور حول كوكب الأرض ما يقرب من 3 آلاف مركبة فضائية، ويتضاعف هذا العدد باستمرار نتيجة زيادة عدد الأقمار الصناعية الصغيرة، وتساعد هذه الأقمار في توفير بيانات مهمة لتوقعات الطقس، كما يسهل نظام “تحديد المواقع العالمي (GBS) System Positioning Global الخاص بالأقمار الصناعية عملية تنقل الأشخاص من مكان إلى آخر، حيث غدت الأقمار الصناعية تقدم عددًا من الخدمات الحيوية لا غنى عنها اليوم، من بينها:
- تغيير نمط الإنفاق: تعتمد كل المعاملات المالية بدءًا من معاملات سوق الأوراق المالية حتى دفع الاشتراكات الشهرية للمواقع الإلكترونية سواء العلمية أو الثقافية أو الترفيهية على خدمات الموقع والتوقيت عبر الأقمار الصناعية لتحقيق الأمان، ودون الأقمار الصناعية لن يستطيع الجمهور الدفع عن طريق “جوجل باي”Pay Google أو السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي.
- إنقاذ الأرواح: يمكن لتقنيات الأقمار الصناعية في هذا الصدد التنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية مثل البراكين، والأعاصير، والفيضانات، وحرائق الغابات، والعواصف الاستوائية الناجمة عن التغييرات المنُاخية، ففي هذه الحالات، تصبح الأقمار الصناعية وسيلةً لرصد تلك الكوارث ودراسة عواملها وأسبابها وسُبل حلها والتعامل معها، وربما الحيلولة دون وقوعها، وبالتالي تدعم الجهود الرامية إلى إنقاذ الشعوب المتضررة من التغييرات الطبيعية.
- المراقبة والتجسس: تستطيع الأقمار الصناعية تصوير أي مكان على سطح الأرض من خارج الغلاف الجوي، بالتالي تحديد أماكن الخارجين عن القانون ومجرمي الحرب والإرهابيين الدوليين.
- وقف القراصنة: في إطار إرسال جميع السفن العملاقة إشارات تتبع بمواقعها، فإنه في حال غياب هذه الإشارات، يُمكن للأقمار الصناعية تنبيه السلطات إلى وجود شيء مُريب. وغالبًا لا يحمل القراصنة والصيادون غير الشرعيين منارةً، أو قد يوقفون تشغيلها لتجنب كشفهم. وفي هذا السياق، يمكن للأقمار الصناعية عالية الدقة التقاط صورًا للقوارب باستخدام تقنية تُسمى “الرادار ذي الفتحة الاصطناعية”Radar Aperture Synthetic .
- اكتشـاف الأنواع المُهددة بالانقراض: تُستخدم تقنيات الأقمار الصناعية لالتقاط صور العديد من النباتات والحيوانات في الغابات والأماكن النائية لتحديد الأنواع المُعرضة للانقراض بسبب التغييرات المناخية والصيد الجائر، وبالتالي الحفاظ على التنوع البيولوجي.
- البحث عن الحياة: تُستخدم الأقمار الصناعية التي تدور حول كوكب الأرض في البحث عن حيوات أخرى على كواكب تتوفر فيها سبل الحياة كالأرض.
سابعًا: مستقبل الإعلام وعلوم الفضاء
تمهيد: الميتافيرس
قبل الخوض في الحديث عن مستقبل الإعلام وعلوم الفضاء، يجب أن نتطرق أولًا إلى تقنية “الميتافيرس” لما تمثله من نقلة نوعية في مجال الاتصالات ستلقي بظلالها عاجلًا أو آجلًا على جوانب حياتنا كافة وليس على الإعلام أو علوم الفضاء فحسب.
يُعرف “الميتافيرس” Metaverse بأنه مجموعة لامتناهية من العوالم الافتراضية يمكن إنشاؤها عبر مساحات مختلفة داخل شبكة الإنترنت، مثل تلك العوالم التي تحدث عنها الفيلم الأمريكي “اللاعب الأول يستعد” Ready Player One للمخرج “ستيفن سبيلبرج” Steven Spielberg الصادر عام 2018، حيث يجسد الفيلم واقع البشرية في عام 2045، لكن يبدو أن البشرية ستعيش هذا الواقع بصورة أسرع مما توقع الفيلم، فتحدث كافة التفاعلات الإنسانية عبر نظارات الواقع الافتراضي VR والواقع المُعزز ARالمدعومة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية، وهذه الثلاثية هي مفاتيح الدخول إلى عالم الميتافيرس، فبدلًا من الدخول إلى هذا العالم الجديد عبر شاشات الكمبيوتر وأجهزة الهواتف الذكية، سوف يتم الدخول إليه عبر نظارات الواقع الافتراضي المستخدمة في ألعاب الفيديو المتطورة حاليًا، حيث سيتم إعادة تصميمها كي تصبح بديلًا للهواتف الذكية، وسيتم دمج تقنيات الواقع المعزز فيها التي تعرض جميع المعلومات الخاصة بأي شيء تقع عليه العين في الواقع الحقيقي “الفضاء العمومي” كي تتصل بالجيل الخامس للإنترنت. ونظرًا لأن جميع التفاعلات الإنسانية التي سوف تتم خلال عالم الميتافيرس هي ثلاثية الأبعاد، أي تتم في بيئة اصطناعية تحاكي البيئة الحقيقية، حيث يتواجد الأفراد بأنفسهم داخلها، ويصنعون الأحداث بأفعالهم وتحركاتهم الفعلية، وليس عبر لوحات المفاتيح وكاميرات الفيديو فحسب، كان من الضروري إيجاد وسيط قوي للغاية يسمح بنقل كافة هذه البيانات العملاقة في زمنها الحقيقي وبسرعة عالية جدًا، وهنا تأتي أهمية الجيل الخامس للاتصالات اللاسلكية الذي يعد وسيطًا يضمن خلق هذا العالم الجديد.

وكان كاتب روايات الخيال العلمي الأمريكي “نيل ستيفنسون” Neal Stephenson أول من استخدم مصطلح Metaverse في رواية “تحطم الثلج” Snow Crash عام 1992. وتتكون الكلمة من مقطعين؛ المقطع الأول Meta، ويعني “ما وراء”، والمقطع الثاني Verse وهو اختصار كلمة Universe بمعنى “العالم”، وبهذا يكون المقطعان معًا كلمة “العالم الماورائي” أو “ما وراء العالم”. وقد قصد “ستيفنسون” من استخدم مصطلح ميتافيرس الواقع الافتراضي المملوك للشركات الكُبرى التي تتعامل مع العملاء “المستخدمين” كأنهم أناس يعيشون في دولة ديكتاتورية تحكمها هذه الشركات.


وكان “مارك زوكربيرج” Mark Zuckerberg الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك” قد أعلن في أواخر عام 2021 خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين، عن تحول الشركة الأم المالكة لمواقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب إلى شركة ميتافيرس، كما أعلن عن تغير اسم الشركة إلى “ميتا” بدلًا من “فيسبوك”، وهذا التغيير الكبير في إستراتيجية الفيسبوك قد يتبعه تغير آخر في إستراتيجية العديد من الشركات التكنولوجية الكُبرى، وينذر بأن الجيل الجديد القادم من الإنترنت سوف يتحول من فضاء ثنائي البُعد 2D يُستخدم عبر شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية إلى فضاء ثلاثي الأبعاد 3D يمكن الدخول إليه والمشاركة في تفاعلاته والتجول به وليس مشاهدته فحسب، وهو ما يمهد الطريق إلى إلغاء فكرة الهواتف الذكية من الحياة البشرية، ويبتكر سبلًا جديدةً للتواصل البشري، وينشأ مجموعة لامتناهية من العوالم الافتراضية قد يراها البعض مفيدة لصالح التطور البشري، وقد يراها البعض الآخر كابوسًا يهدد بقاء الحياة البشرية.


- استخدامات الميتافيرس
ثَمّة استخدامات عديدة ومتنوعة للميتافيرس؛ من أهمها إجراء العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المستقبلية بتقنيات الميتافيرس، حيث يلتقي ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية معًا بأشكالهم الحقيقية أو الرمزية “أفاتار” في قاعات افتراضية. وربما يدعم استخدام تقنية الهولوجرام مؤتمرات الميتافيرس مستقبلًا، مما يتيح الاستغناء عن نظارات الواقع الافتراضي.
بالإضافة إلى ذلك يمكن تأسيس شركة عبر الإنترنت ليس لها مكان فعلي في الواقع، إذ يمكن بناء مقر افتراضي لها داخل الميتافيرس محدد بالعنوان والمكان والموقع، وتستطيع من خلاله استقبال العملاء. كما يمكن بناء أماكن افتراضية لإجراء اجتماعات العمل بدلًا من أن تتم عبر تطبيق “زوم” مثلًا. الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات والشركات التي تقدم خدمات تعليمية ودورات تدريبية عبر الإنترنت، حيث تستطيع بناء كيان لها داخل الميتافيرس.
ومن أجل تحقيق ذلك، على الشركة أن تقوم بشراء قطعة أرض افتراضية عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى فريق التصميم والتطوير الخاص بها بناء مقرها فوق هذه الأرض، حيث يتم تصميم المبنى والمكاتب الداخلية ومناطق خدمة العملاء وكافة التفاصيل الأخرى داخل هذا المبنى الافتراضي، ثم يقوم الموظفون أو العملاء بالدخول إلى هذا المبنى عبر أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المُعزز عن طريق ارتداء النظارة الافتراضية والتجول داخل المبنى ومقابلة أحد الموظفين المختصين على سبيل المثال.
أما عن الاستخدامات الأكثر رواجًا في العقارات الافتراضية هي بناء مساحات لممارسة ألعاب الفيديو المتطورة، كما يمكن شراء قطعة أرض تُخصص للتجمعات العامة وإقامة الحفلات المتعددة، أو لتأسيس عيادة طبية تعالج المرضى عن بُعد، أو بناء محل خاص بشراء الملابس، أو حتى تشييد منزل واستقبال الضيوف فيه.


- في عصر الميتافيرس
مع انتشار تقنية الميتافيرس على نطاق واسع محليًا وعالميًا، وتربعه على عرش الاتصالات ستختفي الوسائل الإعلامية الحالية سواء التقليدية مثل الصحف والإذاعة والتليفزيون، أو الإلكترونية مثل المواقع الإخبارية تدريجيًا، لتحل محلها نظائرها في العالم الافتراضي “الميتافيرس”، أو وسائل جديدة لم يكشف عنها المستقبل بَعد، فيذكر رائد صحافة الذكاء الاصطناعي وإعلام الميتافيرس المصري “د/ محمد عبد الظاهر” أن صحافة الجيل السابع Journalism 7G ستبدأ في الاعتماد على “الرقائق الإلكترونية الدقيقة” المزروعة في الدماغ البشرية في جميع مراحل الاتصال، مما سيعزز هذا الجيل من وسائل الإعلام والاتصال بين البشر.
وستعتمد صحافة الجيل السابع على أدوات وحلول جديدة ومتقدمة للغاية لتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بكل شيء حولنا؛ الأشخاص والمجتمعات والمؤسسات والأحداث، وسيُتاح إنشاء سجل حالة مفصل لكل فرد أو مجموعة أو طائفة في المجتمع قبل التنبؤ بالأخبار المتعلقة بهم، مثل التنبؤ بحالة الطقس أو الأسواق المالية أو التطورات المستقبلية بناءً على ما حدث سابقًا. وفي عصر صحافة الجيل السابع، ستقوم عملية إنتاج الأخبار على البيانات السابقة للأحداث سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وستعتمد صحافة الجيل السابع أيضًا على الإسهامات الفردية والاتصالات المباشرة بين البشر عبر شرائح إلكترونية دقيقة في ظل اختفاء محطات الإذاعة والتليفزيون والمنصات الإخبارية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، ليحل محلها صور ومحتوى تلقائي يبث من محطات مركزية وأقمار صناعية متعددة، ويعمل عبر موجات كهرومغناطيسية ذكية يلتقطها الجمهور عبر الشرائح الإلكترونية المثبتة في أدمغتهم، ومن خلال إنترنت الأجسام الذي سيعد أفضل طرق التواصل وقتها.
ولكن عند الحديث عن مستقبل الميتافيرس يصعب التكهن بنمو تلك التجربة عالميًا بالصورة التي تطمح إليها شركة فيسبوك بسبب وجود عدة تحديات تكنولوجية وتنظيمية.
- التحديات التكنولوجية:
يمكن رصد 5 تحديات تواجه نمو الميتافيرس خلال السنوات الخمس القادمة وهي:
- السرعة المتباينة للإنترنت حول العالم: هناك دول بدأت تجاربها على شبكات الجيل الخامس، وأخرى تعمل بنظام الجيل الرابع، والعديد من الدول حول العالم لاتزال عالقة في شبكات الجيل الثالث، مما يجعل التمتع بأية تقنيات جديدة يوفرها الميتافيرس مرهونة بتوفر إنترنت سريع على مدار الساعة، مما يمثل تحديًا كبيًرا أمام نجاح تلك التقنيات على نطاق عالمي واسع.
- خصوصية الأفراد: في عالم الميتافيرس يحتاج كل مستخدم إلى اتصال يمكن التعرف عليه بشكل فريد مشابه لعنوان “بروتوكول الإنترنت” IP – المُعرّف الرقمي لأي جهاز مرتبط بشبكة المعلومات” – وهذا يعني أنه يمكن استخدام سماعة رأس لتتبع الأشخاص وتحديد أماكنهم رغمًا عنهم. ويمكن استغلال الأفراد الذين يستخدمون الكاميرا مع أجهزة الميتافيرس وخداماته المتطورة لاختراق بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.
- التوافق والحرية في التفاعل مع المنصات المشابهة: يواجه الميتافيرس تحديًا كبيًرا في السماح للمستخدمين بالتفاعل بحرية مع المنصات الأخرى، حيث لا يُسمح للمستخدم بإعادة إنشاء المحتوى الذي أنشأه من قِبل UGC على منصات أخرى. وهو ما قد يتيح إمكانية التشغيل البيني الحقيقي بين الأنظمة الأساسية، حيث يجب على الشركات التي تمتلك هذه الأنظمة الأساسية التخلي عن بعض السيطرة على محتوى قواعد اللاعبين وتجربة المستخدم. فعلى سبيل المثال انتقلت شركة “سوني” Sony، وهي شركة كانت تسيطر بقوة على طُرق ممارسة اللاعبين عبر الأنظمة الأساسية، فسمحت مؤخرًا للمستخدمين بالتفاعل بشكل متكرر مع اللاعبين على وحدات التحكم الأخرى. وفي ظل غياب تلك السمة قد تتعرض شعبية الميتافيرس للخطر، وتصبح أقل تداولًا عالميًا.
- زيادة الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة في الاعتماد على الميتافيرس: يتطلب الميتافيرس تقنيات تكنولوجية وأدوات متطورة للغاية ومحدثة باستمرار قد تكون بعيدة تمامًا عن العديد من الدول النامية والفقيرة، ولا تستطيع بنيتها التحتية تحملها أو التعامل معها، وهو تحد كبير يواجه انتشار الميتافيرس عالميًا.
- تعزيز الثقة بين الميتافيرس والشركات المنافسة لضمان تدفق الإيرادات بعيدة عن المشكلات التقنية والتنافسية: يتعين على الميتافيرس ضمان ثقة اللاعبين الرئيسين في عالم التسويق والألعاب الرقمية، وضمان تدفق الإيرادات والوصول إلى الجمهور، وكذلك ضمان استمرارية بيئة العمل الافتراضي بعيدًا عن مشكلات الغلق من قبل الحكومات، أو بعض القوانين التي تعيق ذلك، فلا يمكن للشركات العملاقة استثمار ملايين الدولارات في الفضاء الافتراضي دون توفير ضمانات تؤمن تلك الاستثمارات في المستقبل.

- التحديات التنظيمية
- القواعد المهنية والأخلاقية: القواعد المهنية والأخلاقية المتعلقة بنشر المحتوى، وحقوق الملكية الفكرية والقواعد الضابطة لذلك، واختراق خصوصيات الآخرين كلها تحديات سوف تواجه تقنيات الميتافيرس في المستقبل، فكيف يمكن وضع ضوابط حول نوعية المستخدمين المتفاعلين داخل المحيط الاجتماعي، أو العملاء داخل المحال التجارية، أو التجارة غير القانونية في عالم الميتافيرس؟.. كيف يمكن تطبيق القوانين ضد الانتهاكات الأخلاقية بين الأفراد في ظل تباين القوانين الإلكترونية في مختلف دول عالم، وفي ظل عدم التعرف بصورة كاملة على هوية المستخدمين، وحتى لو تم التعرف عليهم، فوفقًا لأي قانون يمكن التعامل معهم؟.. هل يمكن حظر منتهكي ضوابط لعبة، أو حملة ترويجية، أو تجربة افتراضية داخل محيط عمل أو فضاء خارجي؟..
- التحديات القانونية: هناك العديد من التحديات القانونية التي تحتاج إلى ضوابط دولية، ومنظمات عالمية تنفذ هذه التشريعات القانونية والقواعد الأخلاقية. وهي معضلة صعبة خاصة في ظل اختلاف النُظم القانونية من دولة إلى أخرى. وبالإضافة إلى ذلك هناك تباين شديد بين الدول والمنظمات في وضع القواعد الأخلاقية والمهنية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة وحلوها، فكيف يمكن وضع تشريعات ضابطة للميتافيرس؟.
- حراسة البوابة الرقمية: ويُقصد بها المواضع التي يصطدم فيها الميتافيرس مع حكومات الدول وسلطاتها، فقد عانت العديد من الدول من حجم المعلومات المزيفة التي كانت تتداول عنها عبر فيسبوك سابقًا، واضطرت بعض الدول إلى مراقبة الفيسبوك، أو حجبه، أو رفع دعاوى قضائية ضده. وسوف يواجه الميتافيرس التحديات نفسها إن لم يجد آلية معينة للسيطرة على الانتهاكات والمحتوى الزائف ضد بعض الدول والمنظمات الدولية.
2. مستقبل علوم الفضاء “استيطان الفضاء”
على الرغم من اتساع علوم الفضاء وتشعبها في أكثر من مجال، إلا أن تظل محاولات استيطان الفضاء أو البحث عن حياة أخرى خارج كوكب الأرض هي القضية الرئيسة التي تشغل أغلب العلماء والباحثين. وقد أجرى الكثير من الباحثين بعض الأبحاث والتجارب في هذا الميدان، وتوصلوا إلى نتائج واعدة تبشر بوجود أمل كبير في العيش خارج الأرض. وسأستعرضُ بعضًا من هذه التجارب ونتائجها خلال السطور القادمة.

- توليد الطاقة والأكسجين
لايزال العثور على مصادر طاقة مستدامة وفعالة أحد أكبر التحديات في الفضاء، حيث تتطلب الرحلات الفضائية طويلة المدى كالرحلات إلى كوكب المريخ كميات هائلة من الطاقة، مما يجعلها باهظة التكاليف المادية والتقنية، كما يضيف الوقود وزنًا هائلًا إلى المركبة الفضائية. ويطرح تخزين الطاقة تحديات تقنية جديدة، حتى إن تم معالجة هذه التحديات، فلايزال استيطان الفضاء على المدى الطويل يحتاج إلى مصادر طاقة من البيئة المحلية أو الموقع مع النظر إلى عدم إمكانية الاعتماد على شحنات من الأرض بشكل دائم.
وقد سعى الباحثون في هذا المشروع إلى إيجاد حل مُجد من الناحية الاقتصادية والتقنية للبعثات الفضائية على المدى الطويل من خلال اختبار المركبات الموجودة على المريخ أو بالأحرى “استغلال الموارد في الموقع” ISRU، وقد عزز هذا المشروع الأدلة التي تشير إلى أن ثاني أكسيد الكربون الذي يشكل 96% من الغلاف الجوي للمريخ، ووقود المغنيسيوم الذي يشكل 4% من تربة المريخ، يمكن أن يكون مصدرًا أساسيًا للوقود على هذا الكوكب.
كما طور الباحثون دراسة تصميم أولي لنظام توليد الطاقة الكهربائية كي يناسب مساحة مستوطنة فضائية صغيرة، فعلى الرغم من أن الطاقة النووية والخلايا الكهروضوئية PV والبطاريات هي التقنيات الرئيسة المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية في أنظمة الفضاء، إلا أنها تشهد ترديًا ملحوظًا بمرور الوقت، وتعد عالية الكتلة نسبيًا.
وفيما يتعلق بالمستوطنات الفضائية الدائمة التي تحتاج إلى طاقة مستمرة، فقد استخدم الباحثون البديل المتمثل في الطاقة الشمسية المركزة إلى جانب التخزين والمحرك الحراريين من أجل بناء نظام لتوليد الطاقة. وقد تم بناء منشأة تخزين الطاقة من مواد محلية المصدر ومكونات عالية التقنية – محرك حراري وجهاز استقبال وعاكسات – مدمجة وخفيفة. ويمكن تطبيق هذا النظام بسهولة في المستوطنات الفضائية وتقديم كفاءات تحويل عالية للطاقة. وتعد تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة حلًا ممكنًا لاستكمال التطبيقات الكهروضوئية على الأرض.
أما عن توليد الأكسجين فهو أحد التحديات الرئيسة في تطوير مستوطنة فضائية على سطح كوكب المريخ بالنظر إلى أن 96% من غلافه الجوي يتكون من ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك وجد العلماء أن كميات هائلة من الأكسجين في تربة المريخ ترتبط بمعادن أكسيد الحديديك وأملاح البيركلورات. وتشير التطورات في بحوث علوم الأحياء المجهرية إلى احتواء تربة المريخ على كمية كافية من الأكسجين تدعم استقرارًا طويل المدى على سطح هذا الكوكب.
وقد طور الباحثون في هذا المشروع تكنولوجيا مفاعل حيوي لاستخراج الأكسجين باستخدام بكتيريا قادرة على النمو على الأقطاب الكهربائية وحل ركائز معدنية معينة من أجل توليد الأكسجين الغازي. كما أظهرت نتائج المشروع قدرة النظام الكهروكيميائي الحيوي على الاستفادة من أحدث التطورات في علوم الأحياء المجهرية لاستخراج الأكسجين بكفاءة من المواد الأساسية المريخية التي يمكن الوصول إليها بسهولة.
- بناء المستوطنات الفضائية
يتطلب بناء أية مستوطنة أو قاعدة فضائية طويلة المدى تقنيات بناء متقدمة للغاية ذات خواص فيزيائية وكيميائية تختلف بشكل كامل عن المباني المشيدة على الأرض، وكي تكون الهياكل المبنية قابلة للتطبيق، يجب أن تواءم مستويات مختلفة من الجاذبية والضغط الجوي والإشعاع الفضائي.
وتختلف عملية البناء في الفضاء اختلافًا كبيرًا عما هو عليه الحال في الأرض، نظرًا إلى انعدام العمالة البشرية، فلاتزال أساليب البناء الأرضية التقليدية معتمدة إلى حد كبير على العامل البشري، لكن بسبب صعوبة نقل ما يكفي من العمالة البشرية إلى الفضاء في مهمة طويلة المدى، ستكون القوى العاملة محدودة للغاية، مما يستدعي الاعتماد على تقنيات البناء الآلي التي يمكن تشغيلها عن بُعد.
وفي هذا السياق، نظر عدد من الباحثين إلى الحلول الممكنة لتشييد مبان تقاوم العوامل الفضائية، وتحقق البيئة المعيشية المثالية للمستوطنين من أجل الحفاظ على صحتهم الجسدية والعقلية. وبالإضافة إلى ذلك، قام بعض العلماء ببحث مشروعات أخرى تهدف إلى حفر أنفاق تحت سطح المريخ، أو أنابيب حمم بركانية كي تُستخدم كملاجئ طبيعية لأوائل المسافرين إلى الفضاء وكذلك مستوطنيه، حيث إنها ستقوم بحماية رواد الفضاء من الإشعاع السطحي والتفاوت الكبير في درجة الحرارة وتأثيرات النيازك الدقيقة وانفجار عوادم الصواريخ. كما قد تكون بعض أنابيب الحمم البركانية على القمر والمريخ باردة بما فيه الكفاية لاحتجاز مياه متجمدة، مما قد يوفر إمكانية الوصول إلى مورد مهم في حال وجود مياه متجمدة بالفعل.
- توفير الماء والغذاء
تناول عدد من الباحثين في مجال الفضاء قضية رئيسة أخرى، وهي ضرورة توفير مصادر غذائية مستدامة للمستوطنين نظرًا إلى انعدام الجدوى البيئية والاقتصادية في الاعتماد على استيراد الغذاء بانتظام من الأرض. وتعتمد أية محطة تقع على سطح القمر أو المريخ على منشآت إنتاج الأغذية المحلية، حيث سيكون من المستحيل الاعتماد على إمدادات غذائية منتظمة من الأرض.
وقد طور الباحثون في هذا المشروع دفيئة آلية لحضانة الطحالب وزراعتها، حيث يُعول على الطحالب أن تكون مصدرًا غذائيًا مهمًا غنيًا بالبروتين للمستوطنين لأنها تحتوي على مجموعة من الدهون والكربوهيدرات المفيدة. وتتميز الطحالب بعدم إنتاجها كتلة حيوية غير صالحة للأكل، كما أنها تستخدم الماء بفعالية، وتحصد الضوء بكفاءة عالية.
وقام الباحثون بتصميم “مفاعل حيوي ذكي” وبنائه يعمل على نمو الطحالب عن بُعد باستخدام كمبيوتر يمكن برمجته بواسطة المستخدم بناءً على البيانات المقدمة من المفاعل الحيوي، حيث تعمل هذه التقنية على تحسين كفاءة إنتاج الطحالب باستخدام ضوء يبعث بدوره الترددات الضوئية التي تحتاج إليها الطحالب في النمو فحسب، مما يوفر آليات تحكم أكثر كفاءة ويقلل من استهلاك الطاقة.
وبالإضافة إلى الطحالب استخدم الباحثون “المياه الرمادية” كي تنمو النباتات من خلال نظام زراعة مائي لا يعتمد على التربة؛ وهو نظام يزيد من استخدام إمدادات المياه المحدودة المتاحة للمستوطنات المريخية المبكرة إلى أقصى حد ممكن. ففي حالة الزراعة التقليدية في التربة، يتم فقدان 85% من الماء عن طريق التبخر، بينما في نظام الزراعة المائي، تُعلق النباتات في الهواء دون حاجة إلى تربة، ويُستخدم الرذاذ الدقيق لتزويدها بالماء والعناصر الغذائية، حيث يتطلب هذا الأمر كمية أقل من الماء، مما يؤدي إلى الحد من التبخر وإنتاج أكثر. ووفقًا لما يذكره الباحثون، تستهلك عملية زراعة طن واحد من الخس باستخدام نظام الزراعة المائية 10 لترًا من الماء فحسب، بينما في نظام زراعة التربة التقليدية يتراوح استهلاك الماء ما بين 80 و100 لتر. وفي هذه التجربة، بقيت نباتات الخس على قيد الحياة عند زراعتها في ماء نظيف لمدة أسبوع على الأقل، وعند ريها بالماء الرمادي كان نموها أبطأ.
- توفير الاتصالات
ساهم الباحثون في هذا المشروع في تطوير تقنية تسعى إلى محاكاة حاسة اللمس، تسمح للمهندسين بلمس الأشياء فزيائيًا عن بُعد، مما يُعرف بعملية “التشغيل عن بُعد”. وقد صمم الباحثون “ذراع مناورة لمسي” يسمح للمستخدمين بالتحكم في آلات عن بُعد من خلال تقديم إدراك حسي باهتزاز لمس مماثل لأطراف الأصابع البشرية. كما كانت المستشعرات الضوئية المطورة قادرة على تتبع إيماءات اليد البشرية من خلال قفاز لإيصال ردود الفعل اللمسية إلى المستخدم.
وستكون هذه التقنية قادرة على تعزيز كفاءة إدراك المستخدمين في أنشطة التحكم عن بُعد عالية الدقة كالتحكم الدقيق في الأدوات الميكانيكية، أو في الحالات التي تتطلب فيها المهام عن بُعد إمساكًا قويًا وتحكمًا دقيقًا. هذا بالإضافة إلى تزويد مبتوري الأطراف بأطراف صناعية تسمح لهم باستعادة الشعور باللمس، حيث يعمل الباحثون حاليًا مع مبتوري الأطراف لتطوير أصابع بتركيبة آلية تتيح للمستخدمين الشعور بإحساس الأصابع بمستوى مُحسَّن عن الواقعية. ويتميز تعزيز الحواس الذي توفره هذه التكنولوجيا، إمكانات عالية القدرة يمكن استخدامها في العديد من المجلات كاستخدام الروبوتات للتنقيب والإنقاذ على سبيل المثال.
وفي مجال الاتصالات الفضائية أيضًا يرى الباحثون أنه يمكن استخدام “الواقع الافتراضي” VR للاتصال بين الكواكب، حيث توفر تقنية الواقع الافتراضي تجربةً أكثر واقعية للأشخاص الموجودين على مسافات بعيدة، على عكس الاتصالات التقليدية التي تتضمن الصوت أو الفيديو أو كلاهما. كما يرى الباحثون أن تأخر الاتصال بين جسمين كوكبيين تحديًا رئيسًا، فعلى الرغم من صعوبة ملاحظة فترة تأخر الاتصال البالغة 5.1 ثانية بين الأرض والقمر، إلا أن فترة التأخير ترتفع إلى ما بين 3 دقائق إلى 20 دقيقة بين الأرض والمريخ في كلا الاتجاهين، وإلى 4 سنوات بين الأرض ومستوطنة افتراضية في نظام رجل القنطور الشمسي في كلا الاتجاهين. وقد استخدم الباحثون في هذه التجربة واقعًا افتراضيًا لمحاكاة حالات مختلفة بين الأرض والقمر، والأرض والمريخ، والمريخ والمريخ، والأرض ونظام رجل القنطور.
يُذكر أن تقنية الميتافيرس تستطيع أيضًا أن تلعب دورًا فعالًا في تطوير العلوم الفضائية من خلال خلق عالم افتراضي يحاكي عالم الفضاء، يستطيع الإنسان من خلاله سواء كان على الأرض أو داخل مركبة فضائية أن يجري ما يشاء من بحوث ودراسات في سهولة ويسر، ودون التعرض لتحديات السفر الفضائي وما يحيك به من أخطار ويتطلبه من تكاليف مالية ومادية باهظة.
ثامنًا: عراقيل تطور الإعلام وعلوم الفضاء في العالم العربي
ثَمّة عراقيل عديدة تحول دون تطور الإعلام وعلوم الفضاء في عالمنا العربي، بعضها داخلية وبعضها خارجية، إلا أن يمكن إجمالها فيما يلي:
- احتكار التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجالات الاتصالات والإعلام وعلوم الفضاء في أيدي الدول الصناعية الكُبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
- احتكار القرار في الحصول على الموارد الطبيعية واستخدامها في خطط التنمية والتلاعب في أسعار الخامات والخدمات.
- احتكار الوسائل العسكرية التي تتيح التدخل عن بُعد دون الخوض في العمليات الحربية الطويلة والمكلفة.
- احتكار وسائل الإعلام الكُبرى عل الصعيد العالمي، وهي فعالة في تشكيل الرأي العالم العالمي والتأثير عليه وحشده تجاه قضية ما.
- السيطرة على المنظومة المالية الدولية بعد ربطها بالبورصات العالمية، حيث يتحكم فيها أصحاب الشركات الكُبرى وفقًا لمصالحهم الشخصية.
- 6. ضعف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي بشكل عام.
- ضعف التمويل وقلة الخبرات التكنولوجية والعلمية وارتفاع معدلات الأمية في عدد كبير من الدول العربية.
- يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم ما يقرب من 5 مليار شخص وفقًا لإحصائيات عام 2020، في حين يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي ما يقرب من 175 مليون شخص وفقًا لإحصائيات عام 2017، وهو رقم ضئيل جدًا مقارنة بالرقم العالمي.

تاسعًا: مصر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
استطاعت مصر منذ فترة طويلة أن تقتحم ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء في مجالي الإعلام أو علوم الفضاء، وقامت بخطوات واعدة في هذا الميدان من خلال إنشاء عدد من المراكز والجامعات والكليات المعنية بدراسة العلوم التكنولوجية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، وكذلك تأسيس وكالة الفضاء المصرية عام 2018.
ففي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تأسيس “مركز تكنولوجيا النانو المصري” عام 2008 وفقًا لمبادرة الحكومة الخاصة بدعم البحوث الصناعية الحديثة. ويستهدف هذا المركز المساهمة في تطوير البحوث الحديثة التي تدعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد البشرية، وتعزيز تطبيقات التكنولوجيا النانوية في جميع قطاعات التنمية الاقتصادية بالدولة. وتمثل تكنولوجيا النانو طفرةً غير مسبوقة في مجالات عديدة كإنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وخلق مواد متطورة لها صفات فريدة في مجال الصناعات الثقيلة، وخلق المواد المستخدمة في المجالات الهندسية والطبية والصيدلانية. وفي عام 2019 أنشأت جامعة القاهرة كلية “النانو تكنولوجي للدراسات العليا” المعنية بالعلوم البينية المتعددة في الفيزياء، والكيمياء، وعلم المواد، وعلم الأحياء، والطب، والهندسة، وربط هذه الحقول المستقلة معًا بتقنية النانو طبقًا للمعايير المعتمدة عالميًا.
وتَقانة النانو هي علم الجزيئات متناهية الصغر أو علم الصغائر، ويدرس معالجة المادة على أساس المقياس الذري والجزيئي، ويهتم هذا العلم بابتكار تقنيات تقاس أبعادها بالنانومتر، وهو جزء من الألف من الميكرومتر، أي جزء من المليون من الميليمتر. ويتعامل النانو مع قياسات ما بين 1 إلى 100 نانومتر، أي أنه يتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح ما بين 5 ذرات إلى ألف ذرة، وهي أبعاد أقل كثيرًا من أبعاد البكتيريا والخلية الحية. وكانت المفاهيم الأولى للنانو قد طُرحت لأول مرة في عام 1959 من قِبل الفيزيائي الأمريكي الشهير “ريتشارد فاينمان” Richard Feynman خلال محاضرة له بعنوان “هناك مساحة كبيرة في القاع”، حيث تحدث عن إمكانية صنع مُركبات عديدة عن طريق التلاعب المباشر بالذرات.

وفي عام 2012 تم تأسيس مدينة “زويل للعلوم والتكنولوجيا” باسم العِالم المصري الفذ “أحمد زويل” الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وهي مدينة علمية مستقلة وغير ربحية تهدف إلى تطوير العلوم الحديثة عن طريق تقديم خدماتها التعليمية إلى النوابغ العلمية المصرية. وتضم المدينة “جامعة العلوم والتكنولوجيا” التي تعمل على تدريب نخبة من الطلاب، تم انتقاؤهم بعناية فائقة لمنحهم فرصة المشاركة البناءة في البحث العلمي في المجالات العلمية الحديثة والهندسية.
وتضم البرامج الدراسية بالجامعة في مجال الهندسة: “الهندسة البيئية، وهندسة تكنولوجيا النانو، وهندسة الطاقة المتجددة، وهندسة العمليات الحيوية والطاقة، وهندسة الفضاء، وهندسة المعلومات والاتصالات”، وفي مجال العلوم: “علوم الطب الحيوي، وعلم المواد، وعلم النانو، وفيزياء الأرض والكون”.
كما تضم الجامعة “مركز علم المواد”، وهو مركز أبحاث متعدد التخصصات يركز على تطوير مواد جديدة لتطبيقها على التقنيات المطلوبة في عصرنا الحالي، وتلك التي يمكن أن تسهم في التخفيف من حدة المشكلات الحالية المتعلقة بالصحة والطاقة والمياه في مصر. ويشمل نطاق أبحاث مركز علم المواد على مجالات عديدة من بينها: تصميم المواد النانوية وتصنيعها لتحسين الظروف الصحية والبيئية، وكذلك التطبيقات المستخدمة العقاقير الذكية الجديدة، وقنوات توصيل الجينات، والهياكل النانونية الخاصة بهندسة الأنسجة، وأبحاث الطب التجديدي، ومواد معالجة المياه.

أما في مجال علوم الفضاء، فقد أنشأت الحكومة “وكالة الفضاء المصرية” في يناير 2018، وهي مؤسسة اعتبارية تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتهدف إلى استحداث علوم تكنولوجيا الفضاء ونقلها وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من قلب الأراضي المصرية.
ومن أبرز أهداف هذه المؤسسة:
- وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال امتلاك علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من قِبل المجلس الأعلى للوكالة ومتابعة تنفيذه.
- توفير مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني.
- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية وتنميتها في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والمعاهد والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي ذات الصلة بمجال عمل الوكالة لاعتمادها تصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
- متابعة اعتماد المواصفات القياسية وتنفيذها في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
- تنسيق وإدارة واستخدام بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

وكانت مصر قد أطلقت عددًا من الأقمار الصناعية في المجالات العلمية والعسكرية بالإضافة إلى الاتصالات منذ ما يقرب عن ربع قرن من الزمان بلغ عددها 9 أقمار، وكان أولها قمر “نايل سات 101” في أبريل 1998 الذي خرج من الخدمة في فبراير 2013، وأخرها قمر “نايل سات 301” في يونيو 2022، وسيكون هذا القمر بديلًا لقمر “نايل سات 201” الذي سينتهي عمره الافتراضي عام 2028.
ويعد قمر “نايل سات 301” أحدث جيلًا من الأقمار الصناعية السابحة في الفضاء حاليًا، وله مميزات تكنولوجية غير متوفرة في سائر الأقمار أخرى ستمكنه من مواصلة المنافسة في مجال البث. ويضم القمر “38 قناةً قمريةً” مقابل 26 قناة في نايل سات 201، ويشمل نطاق تغطيته دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، ويهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية – الأفريقية.
وتشمل إمكانات القمر الجديد تقديم خدمات الإنترنت واسع النطاق لتغطية مصر بأكملها، وكذلك المشروعات الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط خاصة حقل “ظُهر”.
وقد صُنع قمر “نايل سات 301” وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه من تحديد أي مصدر للتشويش ومعالجته ذاتيًا بهدف تأمين القنوات التليفزيونية العاملة عليه، كذلك القيام بالمناورات الهوائية بهدف تغيير مناطق التغطية وفقًا للحاجة.
عاشرًا: النتائج والتوصيات
- مع التطور المتسارع والمستمر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستشهد الوسائل الإعلامية وعلوم الفضاء طفرةً كبيرةً خلال السنوات القادمة سواء في مجالي التغطيات الإعلامية أو التجارب الفضائية.
- ستزداد معدلات الجرائم الإلكترونية ومحاولات اختراق خصوصيات الأفراد والمؤسسات، وكذلك الجهات الحكومية سواء المدنية أو العسكرية أو الأمنية بسبب اعتماد العالم على التقنيات التكنولوجية في مجال الاتصالات، مما يستدعي ضرورة وضع ضوابط رقمية تحول دون ذلك.
- سيتوقف التطور الإعلامي والفضائي على الدول التي تمتلك تقنيات تكنولوجية فائقة خاصة في مجال سرعة الإنترنت أو العلوم الحديثة، مما سيخلق فجوةً كبيرةً بين الدول المتقدمة والدول النامية، وبالتالي سينشطر العالم نصفين؛ عالم متطور يسيطر على عالم متخلف، ويتحكم في مقدراته الوطنية.
- ستختفي الوسائل الإعلامية التقليدية كالصحف والإذاعة والتليفزيون تدريجيًا في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة المعتمدة على الواقع الافتراضي “الميتافيرس”، مما سينجم عنه انتقال أصحاب المهن الإعلامية كالصحفيين والمحررين والمذيعين وغيرهم من الواقع الحقيقي إلى الواقع الافتراضي والعمل عن بُعد.
- يرى البعض أن تقنية الميتافيرس ستخلق عالمًا افتراضيًا يجسد العالم الحقيقي بتفاصيله الدقيقة، وستكون السطوة فيه للآلات والروبوتات وليس الإنسان، مما سينعكس بدوره على مناحي الحياة كافة، فعلى سبيل المثال ستُقام المؤتمرات والمحافل الدولية، وتُعقد الصفقات التجارية والاستثمارية، وتتم عمليات التصنيع، وتُنظم الرحلات السياحة والدورات التدريبية والتعليمية والدراسية، وتوفد البعثات الفضائية عن بُعد.
- يرى البعض كذلك أن هناك الكثير من المهن ستقوم بها الروبوتات بدلًا من الإنسان خاصة المتعلقة بالآداب والفنون والعلوم النظرية والتطبيقية كالأدباء، والكُتاب، والرسامين، والممثلين، وأساتذة الجامعة، والإعلاميين، والمهندسين، والأطباء، والكيميائيين، والفيزيائيين، والتكنولوجيين، والآثاريين، لكنني أرى أن العملية الإبداعية الخاصة بالآداب والفنون سيظل مكنونها بأيدي البشر مهما وصلت التكنولوجيا من تقدم وحلت محل الإنسان، فالنفس البشرية المعقدة والمليئة بالمشاعر والأحاسيس المتناقضة والمتغيرة ووليدة اللحظة لن تتمكن الآلة مهما بلغت من تطور أن تعبر عنها أو تبدع أفضل منها.
- إن التطور التكنولوجي قد يتسبب في راحة البشرية وسعادتها وقد يتسبب في معاناتها وتعاستها، وهذا يتوقف على مجالات استخدامها وأهدافها، والأمر في النهاية منوط برغبات الإنسان دائمًا.
- إن الدول التي لا تولي اهتمامًا بالعلوم والتكنولوجيا، لن يكون لها مكان على خريطة المستقبل، وسيصبح مصيرها مرهونًا برغبات الدول المتقدمة وتطلعاتها الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

قائمة المصادر والمراجع
- 1. ابن بريكة عبد الوهاب، وزينب بن التركي، أثر تكنولوجيا الإعلام والاتصال في دفع عجلة التنمية، مجلة الباحث، العدد 7، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2009.
- 2. استيطان الفضاء، مؤسسة دبي للمستقبل، الإمارات، 2022.
- 3. آلاء زومان، هل تنهي الشبكات الاجتماعية عصر الإعلام التقليدي؟، الاقتصادية “جريدة العرب الاقتصادية الدولية”، العدد 6750، 4 إبريل، 2012.
- 4. أهمية الأقمار الصناعية في الحياة اليومية، سلسلة خبرات دولية، العدد 4، 18 فبراير 2021، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري.
- 5. أيمن محمد إبراهيم بريك، تطبيقات الميتافيرس وعلاقتها بمستقبل صناعة الصحافة الرقمية “دراسة استشرافية خلال العقدين القادمين 2022: 2042″، القاهرة، المجلة المصرية لبحوث الإعلام، العدد 78، 2022.
- 6. إيهاب خليفة، الميتافيرس: عالم ما بعد الإنترنت، مجلس الوزراء المصري، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مركز المعرفة، https://www.idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/6288
- 7. خالد وليد محمود، شبكات التواصل الاجتماعي وديناميكية التغيير في العالم العربي، بيروت، دار مدارك للنشر، 2011.
- 8. رفعت عارف الضبع، الإعلام الجديد، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 2019.
- 9. عبد الرحمن محمد سعيد الشامي، الإعلام الجديد والإعلام القديم: التحديات والفرص، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد 125، جامعة الكويت، 2014.
- 10. العربي العربي، مستقبل الإعلام بين التطور التكنولوجي وصناعة التغيير، مجلة الفكر، العدد 10، 2014.
- 11. قينان عبد الله الغامدي، التوافق والتنافر بين الإعلام التقليدي والإعلام الالكتروني، جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، 2012.
- 12. محمد عبد الظاهر، صحافة الجيل السابع وما هو أبعد من عالم الميتافيرس، الإمارات، مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، 2022.
خاص وكالة رياليست – د. محمد عمر سيف الدين – دكتوراه في الأدب الشعبي الفارسي، وخبير في التاريخ والأدب الإيراني – مصر.