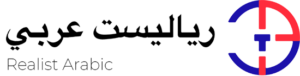بغداد – (رياليست عربي): في زمن تتقاطع فيه الجغرافيا مع المصالح، والقيم مع الوقائع، يشهد العالم لحظة فارقة لم تعد فيها المعادلات الكلاسيكية صالحة للفهم أو للتفسير. فالحرب لم تعد مجرد إطلاق نار، بل إعادة تعريف للمكان والزمان والسلطة. وما نشهده اليوم ليس فقط سلسلة من الأزمات المتناثرة، بل شبكة متداخلة من التحولات التي ترسم ملامح عالم يتشكل بصخب وتردد وألم.
لم تكن روسيا لتخوض حربًا بهذه الكلفة لو لم تكن تعتبرها معركة مصيرية تتجاوز أوكرانيا إلى مصير النظام الدولي برمّته. فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ظلت موسكو تنظر بتوجّس إلى تمدد حلف الناتو شرقًا، وترى في كل توسعة تهديدًا مباشرًا لعمقها الاستراتيجي. وحين بلغ التمدد ذروته بمحاولة جذب أوكرانيا إلى الفلك الغربي، قررت روسيا أن تقول: “كفى”، لا بالدبلوماسية، بل بالقوة الصلبة. وبذلك، دخلنا فعليًا في النسخة الحديثة من الحرب الباردة، حيث تحركت روسيا ليس فقط لحماية أمنها، بل لإعادة تشكيل ميزان القوى العالمي، واستعادة مكانتها كقطب لا يُستثنى من القرار الدولي. لم تعد الحرب بين الشرق والغرب نظرية؛ إنها تتجسّد ميدانيًا في سهول دونباس، وشبكات الغاز، وأروقة الأمم المتحدة. فنرى أن روسيا لا تخوض حربًا على أوكرانيا، بل على مشروع الغرب كله في فرض نموذج أحادي للعالم. وهذه الحرب، وإن طال أمدها، فإنها تمثل بداية النهاية لنظام ما بعد الحرب الباردة، وبداية عصر جديد لا يُختزل في قطب واحد.
وفي أقصى شرق آسيا، تزداد سخونة المشهد في بحر الصين الجنوبي، حيث تايوان تمثل النقطة الحرجة في الصراع الأميركي-الصيني. الصين تصر على وحدة التراب، والولايات المتحدة تصر على دعم “الديمقراطية التايوانية”، وبينهما تقف تايوان كنقطة اختبار لمعادلة الردع. المناورات الصينية ليست استعراضًا، بل حسابات دقيقة في توازن الردع. ونرى أن تايوان تمثل نقطة كسر توازن، ولو اشتعلت الحرب هناك، فإنها ستكون إيذانًا بولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بشكل حاد، ولكن بثمن باهظ إنسانيًا واقتصاديًا.
وبين الضغوط البحرية والتجارية، يستمر التنافس الأميركي-الصيني كأحد أعمدة التحول الكوني. لم تعد الحرب تجارية فقط، بل تكنولوجية واستخباراتية ووجودية. من يملك الذكاء الاصطناعي والشرائح الدقيقة يملك مفاتيح السيادة في القرن الحادي والعشرين. هذا التنافس يُدار بمزيج من الحرب الباردة الناعمة والتحالفات الصلبة. العالم لم يعد يتحمل قطبين فقط، بل يحتاج إلى توازن أكثر مرونة. غير أن السلوك الأميركي القائم على الاحتواء يعرقل هذا التعدد، ما يدفع الصين نحو تعزيز خياراتها الدفاعية وربما الهجومية أيضًا.
وفي الجهة الأخرى من العالم، تستمر الحرب على غزة، لا كصراع تقليدي، بل كجرح مفتوح في الضمير الإنساني. تواصل إسرائيل عدوانها العلني بدعم غربي، فيما يُترك المدنيون الفلسطينيون وحدهم أمام آلة القتل. الموقف الدولي الرسمي بطيء، متردد، ويفتقر إلى المصداقية. وأرى أن القضية الفلسطينية ليست فقط صراعًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا لكل العالم. ما يجري في غزة يكشف عن عنصرية مضمرة في بنية النظام العالمي، ويتطلب نهوضًا جديدًا من شعوب الجنوب العالمي لكسر احتكار السردية الغربية.
أما في العمق الإفريقي، فقد بدأت ترتفع أصوات التمرد على الإرث الاستعماري. الانقلابات في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو لم تكن مجرد حوادث عسكرية، بل رسائل سياسية بأن الشعوب ضاقت ذرعًا بالوصاية الغربية. انسحاب فرنسا وظهور روسيا كلاعب بديل، يعيد خلط الأوراق. لكن اليقظة الثورية وحدها لا تكفي. فهذه الانقلابات تمثل يقظة ضد التبعية، لكنها لن تؤدي إلى نهضة حقيقية ما لم تُصغَ أنظمة بديلة نابعة من الداخل، لا مجرد استبدال الهيمنة الفرنسية بالروسية.
المناخ بدوره لم يعد ملفًا بيئيًا، بل أصبح مصدرًا لصراعات مستقبلية وموجات لجوء غير مسبوقة. الكوارث تضرب الجنوب، فيما الشمال يبني الجدران. ما يجري هو ظلم مضاعف: فالغرب ساهم تاريخيًا في التلوث واستنزاف الموارد، ثم يرفض استقبال ضحايا هذا النظام. على الأمم المتحدة أن تعيد تعريف العدالة المناخية لتشمل حق التنقل واللجوء البيئي، وإلا فإن العالم سيتحول إلى جزيرة تغرق ببطء.
في منطقة الشرق الأوسط، الملف النووي الإيراني ما يزال عنوانًا لصراع الإرادات. إيران ماضية في برنامجها، والغرب يراوح في مكانه بين العقوبات والتهديدات. إسرائيل تلوّح بضربات استباقية، والخليج يراقب. فنرى أن هذه الأزمة لن تُحل بالقوة، بل بالحوار الإقليمي الشامل. إيران ليست مجرد “مشكلة نووية”، بل دولة محورية في أمن الخليج والعالم الإسلامي، وتجاهل ذلك هو تجاهل لحقيقة الجغرافيا والتاريخ.
وفي قلب القارة العجوز، ينهض اليمين المتطرف من ركام الأزمة الليبرالية. فوز أحزاب متطرفة في فرنسا وألمانيا يعكس أزمة هوية في أوروبا ما بعد العولمة. إنها عودة مقنّعة للعنصرية تحت ستار الوطنية. فنرى أن صعود اليمين هو عرض لمرض أعمق: فشل الليبرالية في إنتاج عدالة اجتماعية. إن لم تتجدد الديمقراطيات الغربية من الداخل، فستتحول تدريجيًا إلى نُسخ محسنة من الفاشيات القديمة.
التطور التكنولوجي الهائل بدوره لا ينفصل عن هذا السياق. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية، بل سلاح استراتيجي عابر للحدود، وأداة للسيطرة الناعمة والخشنة في آن. من يملك الخوارزميات، يملك القرار. لا بد من حوكمة عالمية عادلة لهذا القطاع، تحفظ سيادة الدول، وتمنع تحول الإنسان إلى رقم في معادلة اقتصادية أو أمنية. التكنولوجيا بلا أخلاق، أشد فتكًا من السلاح النووي.
وأخيرًا، تبقى منطقة الشرق الأوسط مرآة مزدوجة لما يجري: من جهة هناك نضج في التقارب السعودي-الإيراني، ومن جهة أخرى هناك شلل في ملفات العراق، لبنان، وسوريا. دول تتأرجح بين الاستقطاب الخارجي والفشل الداخلي. مشاريع “التطبيع” تفقد زخمها، تحت ضغط الوعي الشعبي العربي المتصاعد. ونرى أن مصير الشرق الأوسط لن تحدده واشنطن أو تل أبيب، بل قرارات شعوبه. الطريق لا يزال طويلًا، لكن الوعي السياسي المتنامي يبشر بتحول حقيقي في العقد القادم.
خلاصة ذلك أن العالم اليوم لا يعيش مجرد أزمة، بل يعيش تحولًا وجوديًا عميقًا، حيث تُعاد كتابة قواعد اللعبة الدولية. كل حرب، كل أزمة، كل تحالف أو انشقاق، ليس حدثًا معزولًا، بل لبنة في جدار نظام عالمي جديد يُبنى من ركام النظام القديم. ومَن لا يقرأ التحول جيدًا، سيتحول إلى ضحيته. العالم يسير نحو نظام متعدد الأقطاب، هش أخلاقيًا، سريع تكنولوجيًا، ومتغير سياسيًا. وفي هذا المشهد، لا مكان للثابت، ولا أمان للغافل.
خاص وكالة رياليست – عبدالله الصالح – كاتب وباحث ومحلل سياسي – العراق.