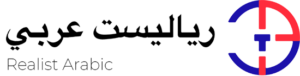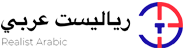القاهرة – (رياليست عربي): على الرغم من مرور ما يقرب من ٢٠ عامًا على وفاته، لا يزال اسم أديبنا المصري الفذ “نجيب محفوظ (1911: 2006)” متداولًا محليًا ودوليًا على نطاقٍ واسعٍ، كما لا تزال روائعه الروائية الوجه المشرق للرواية العربية المعاصرة شرقًا وغربًا. تُرجمت أعمال محفوظ إلى أغلب اللغات الأجنبية، وتهافت صُناع الدراما في العديد من بُلدان العالم على تحويلها إلى أعمالٍ مسرحيةٍ وسينمائيةٍ وتليفزيونيةٍ.
وقد استطاع نجيب محفوظ تحقيق معادلة بالغة الصعوبة في الكتابة، حيث جمع أسلوبه بين فصاحة العبارة وقوة البيان وعُذوبة الصور التعبيرية وحكمتها، وفي الوقت نفسه سلاسة اللغة وانسيابها على الصفحات مثلما تتدفق مياه النهر من أعالي الجبال في تناغم وانسجام، مما جعل القُراء بمختلف مستوياتهم التعليمية والثقافية يقبلون على قراءة أعمال محفوظ بشغفٍ ونهمٍ، ويدركون مقاصدها الظاهرية والباطنية.
وتمثل الحارة المصرية بمعالمها المميزة وشخصياتها الشعبية الفريدة وتفاصيلها الغاصة في صميم المحلية مسرح أحداث أغلب أعمال محفوظ، وهذه المحلية الخالصة هي التي أوصلته إلى جائزة نوبل في الآداب عام 1988. والحارة لدى محفوظ ترمز إلى مصر، إلى العالم، إلى الكون بأكمله؛ قُبحه وجماله، شره وخيره، خِسته ونُبله.
والفتوات والحرافيش والكادحون والمهمشون هم أبطال معظم أعمال محفوظ، هم مَن خلدوا اسمه في ذاكرة الأدب العالمي مثلما خلد ذِكرهم المنسي على صفحات رواياته وقصصه.
وتعد رواية “زُقاق المدق” واحدةً من أروع أعمال محفوظ ومؤلفاته البكر النابضة بقلب الحارة المصرية، وهي بداية ثلاثية روائية كتبها محفوظ في لحظات حرجة من تاريخ مصر الحديث، يرصد خلالها حالة الشعب المصري وما طرأت عليه من متغيرات نتيجة الأحداث السياسية التي وقعت في تلك الفترة.
رأت رواية “زقاق المدق” النور عام 1947 أي عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة (1939: 1945)، وكانت الحماية البريطانية على مصر قد انتهت بموجب “تصريح 28 فبراير 1922″، ثم معاهدة “الصداقة والتحالف الإنجليزية المصرية” عام 1936، لكن وفقًا لبنود الاتفاقية الأخيرة، ظلت القوات البريطانية متمركزة في منطقة قناة السويس، كما تعهدت الحكومة المصرية في حالة نشوب الحرب بتقديم كل المساعدات العسكرية للقوات البريطانية، كما وافقت على السماح للحكومة البريطانية باستخدام موانئ مصر ومطاراتها وسككها الحديدية. وعلى هذا النحو كان استقلال مصر عن بريطانيا استقلالًا صوريًا لم تحظ فيه الحكومة المصرية بسيادة كاملة على أراضيها.

أما الروايتان الأخريان فهما “ثرثرة فوق النيل” عام 1966، و”ميرامار” عام 1967، أي أنهما قد تزامنتا مع نكسة 1967 التي احتلت فيها القوات الإسرائيلية شبة جزيرة سينا إلى أن مُنيت بهزيمة ساحقة على أيدي قواتنا الباسلة عام 1973.
الروايات الثلاث يرصد فيها محفوظ حالة الشعب المصري إبان الحرب العالمية الثانية ونكسة 67 من خلال مجموعة من الشخصيات متباينة التوجهات السياسية تجتمع في مكان واحد؛ (الحارة في زقاق المدق)، (العوامة في ثرثرة فوق النيل)، بنسيون ميرامار في ميرامار)، وتبدأ في إبداء آرائها أو الفرار من واقعها دون إشارةٍ واضحةٍ إلى ما يدور حولها، حيث استخدم محفوظ في الروايات الثلاث الرمزية الشديدة.
ملخص عام لرواية “زقاق المدق”
تدور أحداث الرواية في أوائل الأربعينيات إبان الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على الشعب المصري الممثل في أهل “زقاق المدق” الطيبين المنعزلين عن العالم الخارجي بعالمهم الداخلي. و”المدق” زقاقٌ ينحدر إلى عطفة “الصنادِقيَّة” الواقعة في منطقة قاهرة المُعز الفاطمية.
وكان الزقاق في زمنٍ كان يشع في قلب القاهرة ككوكبٍ دُرِّيٍ، والآن ردمه غبار النسيان. وقد سُمي بـ “المدق” لأنه كان مركزًا للطب القديم، ثم غدا مع مرور الزمان مركزًا للعصارة، حيث تُدق وتُطحن به صنوف البُهارات والتوابل المتنوعة.
يبدأ نجيب محفوظ الرواية بوصفه البديع والدقيق لمعالم الزقاق المميزة وساكنيه؛ قهوة المعلم كِرشة، صالون حلاقة عباس الحلو، دكان عم كامل بائع البسبوسة، فُرن المَعلمة حُسنية، وكالة السيد سليم علوان للعطارة. أما أهل الزقاق فيقطنون في بيتين متلاصقين مكونين من ثلاثة طوابق؛ البيت الأول مِلك السيد رضوان الحُسيني، والبيت الثاني مِلك السيدة سنية عفيفي.
يجمع أهل المدق صلات القرابة والجيرة، وكل واحد منهم له حكاية خاصة به قد تتداخل مع حكاية أو عدد من الحكايات الأخرى مكونةً النسيج العام للرواية، لكن يظل كل واحد من أهل المدق بطل حكايته. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الحكايات وأبطالها.

- المعلم كِرشة: صاحب قهوة كِرشة، وهو متزوج من الست أم حُسين، وحسين ولدهما الوحيد، ولديهما غيره ست بنات متزوجات. على الرغم من أن المعلم كرشة كان له ماضٌ مُشرف من العمل السياسي، حيث شارك في ثورة 1919 والانتخابات البرلمانية أعوام 1923 و1925 و1936، إلا أنه بعد العام الأخير، طلق السياسة وتزوج التجارة، وتحول من رجلٍ ثوريٍ وسياسيٍ إلى حشَّاشٍ متاجرًا ومتعاطيًا. تجارة المخدرات لم تكن داء المعلم كرشة لكن شذوذه الجنسي كان داؤه الحقيقي منذ نعومة أظفاره، فقد أمضى عمره في أحضان الحياة الشاذة حتى خال أنها الحياة الطبيعية.
كان أهل المدق على علمٍ بميل المعلم كرشة إلى مضاجعة الرجال، وعلى الجانب الآخر لم يخجل هو من الإتيان بعشاقه إلى القهوة على مسمعٍ ومرأىٍ من الجميع. عاشت أم حسين سنوات يعتصر قلبها الغم والهم من انحراف زوجها، وتأزمت العلاقة بينهما. أما ابنه حسين فقد آثر العمل في الأورنس (المعسكر الإنجليزي) بالتل الكبير (محافظة الإسماعيلية) هربًا من عار أبيه وتلاسن الناس عليه. كان أخر عشاق المعلم كرشة، فتىٌ يافعٌ يعمل بائعًا في دكان ملابس رجالية بشارع الأزهر أصبح يرتاد القهوة كل ليلة بشكل منتظم، فتربصت أم الحسين قدومه وانتهزت فرصة جلوسه برفقة المعلم، واقتحمت القهوة مهاجمةً الفتى، وأمطرته بوابلٍ من السُباب والألفاظ النابية، وأوسعته ضربًا حتى سال الدم من أنفه، ففر هربًا، ثم أمسكت بتلابيب زوجها، ودار بينهما شجار لفظي وجسدي شاهده زبائن القهوة والمارون بها وساكنو المدق.
- السيد رضوان الحُسيني: صاحب البيت الأول بالزقاق الكائن في الناحية اليُمنى، وهو رجل تقيٌ، ورعٌ، ذو طلةٌ مهيبةٌ. وجهه أبيض مُشرَب بحُمرةٍ ذو لحية صهباء، والنور يشع من غُرَّة جبينه، وملامحه تنضح بهاءً وسماحةً وإيمانًا. السيد رضوان موسر، ويمتلك بضعة أفدنة في حي المرج، ويحب الخير وفَعَّالًا له، فلا يكاد يمر يومًا دون أن يهب مما رزقه الله كأنه مثقلٌ بما لديه من متاع الدنيا. كانت حياته خاصة في مستهلها مرتعًا لخيبة الأمل وألم الفراق، فقد قطع شوطًا طويلًا من عمره في طلب العلم بين أروقة الأزهر دون أن يظفر بشهادة العالمية، كما فقد أبناءه الواحد تلو الآخر، ولم يبق له ولدٌ واحدٌ على كثرة ما خلف من أطفال، فانطوى على نفسه طويلًا في ظلمةٍ غاشيةٍ حتى أخرجه الإيمان من دُجنَّة الأحزان إلى نور الحب، فلم يعد يعرف قلبه كربًا ولا همًا، وانقلب حبًا شاملًا وخيرًا عميمًا وصبرًا جميلًا، وأفرغ حبه على الناس جميعًا. يقول عنه الدكتور بوشي: “إذا كنتَ مريضًا فالمس السيد الحسيني يأتيكَ الشفاء، وإذا كنتَ يائسًا فطالع نور غُرته يُدرككَ الرجاء، وإذا كنتُ محزونًا فاستمع إليه يُبادركَ الهناء”. كان أهل الزقاق يسألون السيد رضوان الرأي والمشورة سواء أخذوا بها أو تجاهلوها.
- الشيخ درويش: كان في عهد شبابه مدرس لغة إنجليزية في إحدى مدارس الأوقاف، وقد عُرف بالاجتهاد والنشاط، وكان ربَّ أسرةٍ سعيدةٍ. ولما انضمت مدارس الأوقاف إلى وزارة المعارف، سويت حالته مثل كثيرين من زملائه غير ذوي المؤهلات العالية، فاستحال كاتبًا بالأوقاف، ونزل من الدرجة السادسة إلى الثامنة، وعُدل مُرتبه على هذا الأساس. حزن الرجل لما آل إليه مصيره حزنًا عميقًا، وثار ثورةً جامحةً، وراح يسعى كل مسعى، ويطرق كل باب، ويقدم الالتماسات والشكاوى لكن دون جدوى. اشتهر أمره في الوزارة كموظفٍ كثير التبُّرم والشكوى والشجار مع زملائه حتى تراءى له يومًا أن يحرر خطاباته المصلحية باللغة الإنجليزية مبررًا ذلك بأنه كادرٌ فنيٌ وليس إداريًا، فتعثر عمله وتعطل، مما دفع مديره إلى معاملته بحزمٍ وقسوةٍ. وذات يومٍ طلب الرجل مقابلة وكيل الوزارة، فدخل حجرة الوكيل، وحياه تحيةً الندِّ للندِّ قائلًا بثقة ويقين: “لقد اختار الله رَجله”، فطلب منه الوكيل أن يُفصح عما يريد، فاستدرك قائلًا في وقارٍ وجلالٍ: “أنا رسول الله إليكَ بكادرٍ جديد”.
على هذا النحو خُتمت حياة درويش أفندي في وزارة المعارف، وهجر أهله وإخوته ومعارفه إلى دنيا الله الواسعة، ومضى في عالمه الجديد وحيدًا بلا صديق ولا مال ولا مأوى، ومع ذلك انتقل إلى حالٍ من السلام والطمأنينة والغبطة لم يعهدها من قبل، فإذا كان قد فقد بيته فالدنيا كلها صارت بيتًا له، وإذا كان قد حُرم مرتبه فالتعلق بالمال انقطع عنه، وإذا كان قد خسر الأهل والأصدقاء فالناس جميعًا غدوا أهله. يُبلى لباسه يأتيه غيره، يحل مكانًا يُرحّب به. هو ذاهل صامت أو مرسل القول كما يحب، لا يدري أين موقعه في نفوس الناس، بيد أنه رجلٌ محبوبٌ، مباركٌ، يستبشر الجميع بوجوده خيرًا، ويقولون عنه: “إنه ولي من أولياء الله الصالحين، يأتيه الوحي باللغتين العربية والإنجليزية”.
- السيد سليم علوان: صاحب وكالة عطارة بالجملة والتجزئة، لم يكن من أثرياء الحرب لأنه على حد تعبيره “تاجر ابن تاجر”. على الرغم من أن الحرب قد أثرت على سوق العطارة بشكل سلبي نتيجة توقف حركة الاستيراد من الهند، لكن الوكالة استطاعت الحفاظ على مركزها في السوق بفضل فطنة السيد علوان وخبرته، فقد أغرت ظروف الحرب الرجل أن يتاجر في سلعٍ لم يكن يعبأ بها من قبل كالشاي، فغامر في السوق السوداء، وربح أموالًا طائلةً. وكان الشاي قد دخل إلى مصر مع الاحتلال الإنجليزي عام 1882، وكان احتساؤه مقصورًا على علية القوم، ثم غدى مشروبًا شعبيًا مع بدايات الحرب العالمية الأولى عام 1914. على هذا النحو خاضت تجارة السيد سليم غمار الحرب الأولى، وخرجت ظافرة، ثم أدركتها الحرب الثانية، فأثقلت موازينها حتى أتخمتها بالمال. السيد سليم متزوج من امرأةٍ سليلة أسرة كريمة، ولديه ثلاثة أولاد؛ محام، وقاض، وطبيب بالقصر العيني لا يكترثون بأمر التجارة أو معاونة أبيهم في عمله. عقب زواجه انتقل من بيته القديم بحي الجمالية إلى قصرٍ منيفٍ بحي الحلمية.

- عباس الحلو: صاحب صالون حلاقة، وهو شابٌ وديعٌ، دَمِث الخُلق، طيب القلب، يميل إلى المهادنة والمصالحة والتسامح، له عينان صافيتان هادئتان. جمعت الصداقة بينه وبين حسين بن المعلم كرشة على الرغم من تباين أخلاقهما.
- حُسين كرشة: ابن المعلم كرشة الوحيد، وهو معروف بشطارته ونشاطه وجراءته. عمل في بادئ أمره في القهوة مع أبيه، لكنهما لم يتفقا، فترك القهوة، وعمل في دكان دراجات إلى أن اشتعل فتيل الحرب، فالتحق بالمعسكرات الإنجليزية. سرعان ما جرى المال بين يديه، ويُسرت له سُبل العيش، فأصبح يرتاد الملاهي والسينمات، ويعاقر الخمر، ويرافق النساء، ويقول عن نفسه: “في بلاد الإنجليز يسمون من كان مثلي في بحبوحة العيش باللارج”، فغدا الجميع يلقبونه “حسين اللارج”، ثم حُرفت الكلمة إلى “حسين الجراج”. مع قُرب انتهاء الحرب، سُرح حسين كغيره من العاملين الآخرين في الأورنس، فعاد مع زوجته سيدة وشقيقها عبده إلى زقاق المدق مرة أخرى، فقابله أبوه بفتور رافضًا مكوثه في البيت، لكن لما طالع نسيب ابنه الشاب الوسيم، انفرجت أسارير وجهه، وتحول اللقاء البارد إلى ترحابٍ حارٍ.
- عم كامل: صاحب دكان البسبوسة المجاورة لصالون الحلو، وهو رجلٌ عجوزٌ، طيب القلب لا يريد من هذه الدنيا سوى شراء كفن يتدثر به إلى مثواه الأخير. بعد وفاة والديّ عباس، شاطر عباس شقته منذ 15 سنة، وغدا كوالده.
- الدكتور بوشي: دكتور أسنان تعلم صنعته دون دخول أية مدرسة أو ممارسة مهنة الطب أصلًا. اشتغل في بداية حياته تمرجيًا لطبيب أسنان في الجمالية، فتعلم منه فنون الطب وبرع فيها. اشتهر بوصفاته المفيدة، وإن كان يفضل الخلع غالبًا كأفضل علاج. يخلع الضرس بقرش للفقراء، وقرشين للأغنياء. يخاطبه أهل المدق والأحياء القريبة بـ “الدكتور”، ولعله أول طبيب يأخذ لقبه من مرضاه!!
- الست أم حميدة: خاطبة الزقاق وبلانته، وهي امرأة ربعةٌ ممتلئةٌ، جاحظة العينين، مجدورة الخدين في الستين من عمرها، لكنها مُعافاة، قوية، ذات صوت عال ولسان سليط. وحميدة ابنتها بالتبني، فالأم الحقيقية كانت شريكة لها في تجارة المفتقة والمُغات، شاطرتها الشقة في ظروف قاسية حتى وافتها المنية بين بين يدي صديقتها تاركةً طفلتها في سن الرضاعة، فتبنتها أم حميدة، وعهدت بها إلى زوجة المعلم كرشة كي تُرضِعها مع ابنها حسين، وبهذا حميدة أخت حسين في الرضاعة.
- الست سنية عفيفي: صاحبة البيت الثاني بالزقاق الكائن في الناحية اليُسرى، وهي سيدة ثرية في الـخمسين من عمرها. تزوجت في شبابها من صاحب دكان روائح عطرية، لكنها كانت زيجة غير موفقة، فأساء الرجل معاملتها، وأشقى حياتها، ونهب مالها، ثم تركها أرملةً منذ 10 سنوات، فكرهت الحياة الزوجية على حد قولها، لكنها الآن ضاقت بوحدتها، فتوجهت إلى أم حميدة الخاطبة تسألها الزواج بشابٍ صغيرٍ. بعد عِدَّة أيام من هذه الزيارة، ذهبت أم حميدة إلى الست سنية حاملةً إليها البشارة، فقد وجدت لها عريسًا في الثلاثين من عمره يُدعى “أحمد أفندي طُلبة”، وهو موظف في قسم الشرطة على الدرجة التاسعة، ومرتبه يبلغ 10 جنيهات شهريًا. غمرت السعادة قلب الست سنية الخالي، وراحت ترمم ما أتلفه الدهر فيها استعدادًا للعُرس المنتظر، فأرسلت في طلب الدكتور بوشي كي يصنع لها طقم أسنان ذهبي بدلًا من أسنانها الساقطة والأخرى الوشيكة على السقوط.
- فرج إبراهيم: قوادٌ يصطاد الفتيات الجميلات ويحولهن إلى بائعات هوى يعملن لحسابه الخاص. هو رجلٌ وسيمٌ ذو هيئة أنيقة يخدع بها الفتيات. ظهر في الزقاق فجأة، وأوقع حميدة في حبائله.

- حميدة: هي الشخصية التي أفرد لها نجيب محفوظ جزءًا كبيرًا من روايته، وجعل أغلب الشخصيات السابقة إلى جانب شخصيات أخرى تلعب أدوارًا رئيسةً وثانويةً في حكايتها. حميدة مجهولة النسب لا يُعرف مَن أبوها، تولت تربيتها الخاطبة أم حميدة عقب وفاة أمها الحقيقية، وعاشت في كنفها حتى شبت. حميدة فتاةٌ جميلةٌ في العشرين من عمرها، متوسطةُ القامة، رشيقةُ القوام، نُحاسيَّةُ البشرة، لها عينان سوداوان مستديرتان في دلال وافتتان، وشفتان دقيقتان رقيقتان، وشعر فاحم تصل ذوائبه إلى ركبتيها.
حميدة متمردة على واقعها الفقير وطامحة إلى حياة مرفهة بعيدة عن زقاق المدق وأهله. كانت تنظر دائمًا إلى صويحباتها العاملات في مشغل الغزل والنسيج وهن يرفلن في فساتينٍ ملونةٍ جميلةٍ تبرز مفاتنهن، ويعقصن شعورهن أو يتركنها مرسلةً ترف خلف ظهورهن، وتتمنى أن تكون مثلهن لا ترتدي ملاءةً لف سوداء ولا منديلًا بأوية مزركش. بعد لقاءات ومغازلات ووعود بحياة فُضلى، يذهب عباس الحلو صاحب صالون الحلاقة بصحبة عم كامل بائع البسبوسة إلى خطبة حميدة. يبيع عباس صالونه إلى رجلٍ عجوزٍ، ويسافر للعمل في المعسكر الإنجليزي بالتل الكبير بناءً على نصيحة صديقه حسين بن المعلم كِرشة حتى يؤمن مالًا وفيرًا يكفي احتياجات حبيبته حميدة وتطلعاتها الكبيرة.
أثناء سفر عباس، يقع حدثان يؤكدان أن حميدة لا تحب سوى نفسها فحسب، وأنها تنظر إلى عباس على أنه مَخرجٌ لها من الزقاق نحو حياة تتمناها وتتطلع إليها منذ نعومة أضفارها. الحدث الأول؛ يتقدم السيد سليم علوان صاحب وكالة العطارة إلى خطبة حميدة، فتوافق، لكنه يصاب بذبحة صدرية، ويسقط طريح الفراش بين الحياة والموت. أما الحدث الثاني؛ فهو ظهور القواد فرج إبراهيم في الزقاق فجأة. يعجب بحميدة ويبدأ في مطاردتها أينما حلت حتى يقنعها بالذهاب معه إلى شقته الفاخرة الواقعة في شارع شريف باشا بوسط البلد. تستقل حميدة التاكسي لأول مرة في حياتها بصحبة فرج، وتمضي بهما السيارة قاطعةً زقاق المدق إلى وسط البلد، وحميدة تنظر من نافذتها منبهرةً بالشوارع الواسعة والمحال الراقية والبنايات السامِقة إلى السماء، إلى أن تتوقف السيارة أمام عمارة شاهقة ذات مدخل أوسع من زقاق المدق تقع شقة فرج بطابقها الأول. تدلف حميدة إلى الشقة مع فرج مشدوهةً بالأثاث الراقي والسجاد المزخرف والتحف الغالية. لا تمضي سوى دقائق معدودات حتى يخبرها فرج بأنها لم تُخلق لتعيش في المدق كمثيلاتها من فتيات الزقاق، بل عليها العيش في بيتٍ كبيته يليق بها وبحُسنها الفتَّان، ويقول لها صراحة إنه يريدها شريكةً له في “السعادة والحب والجاه” لا في الزواج. تدرك حميدة أنه قوادٌ أو كما يقول عن نفسه إنه “سمسار السعادة في هذه الدنيا”. تهرع صوب باب الشقة فلا يعترض طريقها، بل يخرج معها ويوصلها إلى الزقاق بالتاكسي مثلما أتي بها وهو متيقن من أنها ستعود إليه.
تمضي حميدة ليلتها حيرى بين حياة مقِحَفة تنفر منها في المدق وحياة مُنعَّمة تتوق إليها مع فرج. في صبيحة اليوم التالي، تخرج حميدة من المدق، وهي تودع بعينيها نواحي الزقاق الوداع الأخير، قاصدةً شقة وسط البلد. هكذا ألقت بنفسها في أحضان فرج وعالمه الماجن، فيبدأ في إعدادها لتكون إحدى بائعات الهوى في حانةٍ يرتادها العساكر الإنجليز، ويسميها “تيتي”.
على الرغم من الملابس الغالية والحُلي الذهبي المرصع بالماس والجواهر النفيسة والأموال التي تُنثر فوق رأسها وتُلقى تحت قدميها، والرجال الذين يتمنون نظرةً أو إشارةً منها، وجميع الأمنيات التي باتت تتحقق أمام عينيها، كانت حميدة تظن أنها ستظفر في النهاية بقلب فرج وتتزوجه وتعيش حياةً محترمةً كسيدات المجتمع الراقي، لكنها لم تدرك أنها ستظل في عينيه عاهرةً من عاهراته تدر عليه المال، لذا باتت تفكر في التخلص منه حتى تنال حريتها.

بعد زهاء شهرين من اختفاء حميدة، يعود عباس إلى زقاق المدق فرحًا يحمل معه شبكة حميدة؛ عقد ذهبي يتدلى منه قلب رقيق، فيخبره عم كامل أن حميدة قد اختفت من الزقاق، ولا أحد يعلم طريقًا لها حتى أمها قد ذهبت إلى قسم الجمالية ومستشفى القصر العيني بحثًا عنها، لكن لا حياة لمن تُنادي. تتشح الدنيا بأثواب السواد أمام عينيّ عباس، وينغمس مع صديقه حسين كِرشة في سهرات حانة “فيتا” بحارة اليهود.
في إحدى الليالي يخرج عباس من الحانة مُتأبطًا ذراع حسين، ويسيران على غير هدى حتى ميدان الأوبرا، وهناك تقع عيناه على حميدة مستقلةً حنطورًا، فيترك ذراع حسين، ويركض وراء الحنطور حتى يتوقف في شارع فؤاد الأول. تترجل حميدة عن الحنطور متوجهة إلى الحانة التي تعمل بها، وحينها يقرع أذنيها صوتٌ ينادي اسمها. لما رأت حميدة عباسًا، دلفت به إلى حانوت زهور يجاور الحانة اعتادت ابتياع الأزهار منه. راح عباس يسألها عما جرى؟، ولمَ رحلت عن زقاق المدق؟، ومن أغواها حتى تسقط في بئر الرذيلة؟. في البداية أغلظت له القول، ثم جال بخاطرها فكرةً خبيثةً تتخلص بها من فرج، فأخبرت عباسًا بصوتٍ حزينٍ مصطنعٍ أنها شقيةٌ بائسةٌ خدعها شيطانٌ رجيمٌ لا تستطيع الفرار منه، وأنها نادمةٌ عما فعلت بنفسها. يصدقها عباس، ويرق قلبه لها، ويطلب منها أن ترشده إلى طريق فرج حتى يهشم رأسه وينتقم ممَن أجرم في حقه وحقها، وكان سببًا في فراقهما وشقائهما. لما وصل الحديث بينهما إلى هذا الحد، استشعرت حميدة السماح في صوت عباس، وأدركت أنها وصلت إلى مبتغاها، فأخبرته أن فرج يأتي الحانة ظهر الأحد، ولن يجد هناك مصريًا واحدًا غيره، فإذا التبس عليه الأمر ستشير إليه بطرف عينها. افترق الاثنان على هذا الاتفاق، وكل منهما يفكر في حاله؛ عباس يريد الانتقام لشرفه والعودة بحميدة إلى زقاق المدق، أما هي فتريد التخلص من فرج وشد الرحال إلى الإسكندرية حيث تنال حريتها بعيدًا عن فرج وعباس وأهل الزقاق.
أخبر عباس حسينًا بما جرى بينه وبين حميدة، واتفق الصديقان على الذهاب ظهيرة يوم الأحد إلى الحانة كي ينتقما من فرج ويعدا حميدة إلى الزقاق. في اليوم الموعود توجه الاثنان إلى الحانة، وراح عباس يطوف أرجاء المكان بعينيه بحثًا عن فرج، فوجد حميدةً في أحضان زمرةٍ من العساكر الإنجليز تلهو وتقارع الخمر، فجن جنونه، واتقدت النار في عروقه، وأمسك بإحدى زجاجات الجعة الفارغة، وألقها بكل ما أوتي من قوة صوب حميدة، فأصابت الزجاجة وجهها، وانفجر الدم من أنفها وفمها وذقنها، وسال على عنقها وفستانها. راحت تصرخ، فاختلط صراخها بزئير السكارى الهائجين، وتكابل العساكر الإنجليز على عباس يبرحونه ضربًا حتى سقط بينهم بلا حراك. كان عباس يصيح على حسين كي ينجده، لكن حسين الذي لم يخض عراكًا واحدًا في حياته، وقف عند باب الحانة مع الغادين والرائحين يشاهد المعركة الدائرة بقلبٍ مقهورٍ ويدٍ مغلولةٍ وروحٍ مغبونةٍ. جاءت الشرطة بعد قضاء القضاء، وأحاطت بالحانة، فحملوا عباسًا جثةً هامدةً إلى القصر العيني، ونقلوا حميدةً إلى الإسعاف.
في صبيحة اليوم التالي، روى حسين ما حدث إلى أبيه المعلم كرشة، وراح المعلم يروي القصة مرارًا وتكرارًا على مسامع أهل المدق، فذاع بينهم خبر مقتل عباس وما جرى من أمر حميدة بعد هروبها من الزقاق، وأخذوا يزيدون على القصة كما يحلو لهم، وتلك عادة الحكائين. في تلك الأيام تحدث أهل المدق عن اتصال أم حميدة بابنتها بعد مثولها إلى الشفاء طمعًا في جني ثمار هذا الكنز المُترع. ولأن آفة حارتنا النسيان، نسي أهل المدق حكاية حميدة وعباس، وانشغلوا بحكايات جديدة؛ ففي البداية انشغلوا بأمر الساكن الجديد في بيت الست سنية، وكان أحد القَصَّابين وعائلته المكونة من زوجة وسبعة أطفال وفتاة حسناء؛ قال عنها حسين إنها “فلقةُ قمر”. وكان هذا القصَّاب قد استأجر شقة الدكتور بوشي بعد إصرار الست سنية على إخلائها قبل حبس الدكتور الذي أُلقي القبض عليه مُتلبسًا وهو يسرق من جثة عم عبد الحميد الطالبي طقم أسنانه الذهبي. بعد حكاية القَصَّاب وشقته، انشغل أهل المدق بعودة الحاج رضوان الحسيني من الأراضي الحجازية، فعلقوا الثُريات والأعلام، وفرشوا أرض الزقاق بالرمل ومنُّوا أنفسهم بليلة فرحٍ وسرورٍ تدوم ذكراها أيام، وحينها هتف الشيخ درويش: “وما سُمِّيَ الإنسانُ إلا لنسيِّه، ولا القلبُ إلا أنَّه يتقلَّبُ”..
مقهى النجمة (كافه ستاره)
عقب صدور رواية “زقاق المدق” تُرجمت إلى العديد من اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية وغيرها، كما اُقتبست في عدد من الأفلام كان من بينها الفيلم الإيراني “كافه ستاره” أي “مقهى النجمة” عام 2006.
“مقهى النجمة” من إخراج “سامان مُقدم”، وسيناريو وحوار السيناريست والممثل الإيراني اللامع حاليًا “پيمان مَعادي” الحائز على جائزة “الدُب الذهبي” كأفضل ممثل من مهرجان برلين السينمائي الدولي عام 2011، عن دوره في الفيلم الأيقوني “انفصال نادر عن سيمين (جدایى نادر از سیمین)” من تأليف وإخراج صائد الجوائز “أصغر فرهادي”، وهو أول فيلم إيراني يحصد جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2012. والحديث عن پیمان وفرهادي يحتاج إلى صفحات عديدة، فكلاهما وجهان مضيئان للسينما الإيرانية حاليًا، واسمان متداولان في المحافل السينمائية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
لعب بطولة الفيلم كل من: أفسانِة بايجان (افسانه بایگان) في دور “فَريبا”، وهانية تَفاسولي (هانيه توسلى) في دور “سالومة”، ورؤیا تیموریان في دور “مُلوك”، وبيجمان بازيغي (پژمان بازغی) في دور “إبي”، وحامد بَهداد في دور (خُسرو)، وشاهرُخ فروتنیان في “فِريدون”، ونيجار فُروزَندِه (نگار فروزنده) في “كيتي”، ومسعود رايجان (مسعود رایگان) في دور “أبو سالومة”، ونیکو خِردمند في دور “أم فريبا”، وإيرج نوذَري في دور “شاهين”، وكوروش سُتوده في دور أحد رواد المقهى.
وضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار “أمير تَفاسولي (امير توسلى)” الذي يعد حاليًا واحدًا من أشهر واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات الإيرانية، وأغزرهم إنتاجًا، وأنتج الفيلم المخرج والمنتج المعروف “مصطفى شايسته (شركة هدايت فيلم)”.

يروي “مقهى النجمة” في ثلاثة فصول منفصلة متصلة حكايات ثلاث نساء يعشن في إحدى الأحياء القديمة بالعاصمة الإيرانية طهران.
الفصل الأول “فَريبا (أفسانة بايجان)” امرأة في منتصف العمر عالقةً مع زوجها المدمن العاطل فِريدون. تدير مقهى صغير ومتواضع يُسمى “مقهى النجمة”، وتعيل عن طريقه أمها العجوز وأخيها الشاب خُسرو. يعامل فريدون زوجته فريبا بقسوةٍ شديدةٍ، ويسرق حُليها الذهبي، ويهرب، لكن خسرو شقيق فريبا يتمكن من اللحاق به، ويدخل معه في شجارٍ عنيفٍ ينتهي بمقتل فريدون. يأخذ خسرو الذهب، ويذهب إلى صديقه إبي، ويطلب منه المساعدة على الفرار من إيران وإعادة الذهب إلى فريبا. يعطي إبي بعضًا من المال إلى خسرو ورقم هاتف شخص كي يساعده على الخروج من البلاد. تنتهي حكاية فريبا باختفاء خسرو ووفاة فريدون دون أن تعلم فريبا حقيقة ما حل بهما.

الفصل الثاني “سالومة (هانية تفاسولي)” فتاة جميلة تهوى الرسم، وتساعد فريبا في المقهى، وترعى أباها الكفيف، وهي مخطوبة إلى إبي الذي يهيم بها عشقًا، ويمتلك ورشة تصليح سيارات. كل ما يشغل بال سالومة وتتمناه في هذه الدنيا الزواج بإبي، لكن بسبب الفقير وضيق الحال لا يتسنى لهما هذا الأمر. تذهب سالومة إلى استقبال صديقتها العائدة من دُبي كيتي، وهي فتاة جميلة، موسرة، ترتدي ملابس على أحدث صيحات الموضة. تدور شُبهاتٌ عديدةٌ حول سفر كيتي المتكرر إلى دُبي وطبيعة عملها هناك الذي يُدرّ عليها كل هذه الأموال، كما نراها تسعى إلى إقناع سالومة بالسفر معها والعمل في دُبي حتى تدبِر أموال زواجها، إلا أن سالومة ينتابها القلق حيال هذه الفكرة. في تلك الأثناء، يحاول إبي بيع حُلي فريبا المسروق في سوق الصاغة حتى يحصل على مال يعينه على الزواج بحبيبته سالومة، لكن أحد الصَّيَّاغ يشك في أمره، ويهاتف الشرطة، فتتعقب إبي ويُلقى القبض عليه بتهمة بيع ذهبٍ مسروقٍ. يهاتف إبي سالومة، ويطلب منها انتظاره أربع سنوات حتى يُطلق سراحه، ويجتمع شملهما مرة أخرى. في تلك الفترة يظهر رجل غامض يرتاد مقهى النجمة يُدعى “شاهين”، يعجب بسالومة، ويُفهم من نظرات عينيه وأسلوبه في الحديث أنه قوادُ يريد اصطياد فريسة جديدة. يحاول شاهين إغواء سالومة بهيئته الأنيقة ومظهره الثري، لكنها لا ترتاح له، فيذهب إلى أبيها، ويطلبها للزواج. يسدل اليأس أستاره السوداء أمام عيون سالومة بعد إلقاء القبض على إبي وطلب زواجها من قبل شاهين، فلا تجد مفرًا سوى الانصياع إلى صديقتها كيتي والسفر إلى دُبي. تنتهي حكاية سالومة وهي تطرق باب منزل كيتي بعد رحيلها عن الحي.

الفصل الثالث “مُلوك (رؤيا تيموريان)” امرأة في منتصف العمر، ثرية، تمتلك العقار القاطن به جميع أبطال الحكايات. تعاني من وحدةٍ قاتلةٍ، وتود الزواج، فيتعلق قلبها بشقيق فريبا الشاب خسرو غير مبالية بفارق السن بينهما. بعد مقتل فريدون، يذهب خسرو إلى ملوك ويسألها الحصول على بعض المال يساعده على الهروب من البلاد مستغلًا إعجابها به، فتعطيه ملوك كل ما بحوزتها من مال تقريبًا. بعد مرور فترة من الوقت، نرى إبي يطالع باكيًا في إحدى الجرائد تنويهًا مرفق به صورةٍ عن شخص مجهول الهوية لقي مصرعه أثناء الاشتباك مع قوات الشرطة في إثر محاولته الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية، حيث تطلب السُلطات في التنويه من أي شخص يتعرف على صاحب الصورة التوجه إلى أقرب قسم شرطة. يعلم إبي من الصورة المرفقة أن الشخص الصريع هو صديقه خسرو، فيشتري من جميع بائعي الجرائد في المنطقة كل نسخ الجريدة التي نشرت التنويه، ويضرم فيها النار حتى لا تعلم فريبا بما حدث لأخيها. تستشعر ملوك أن مكروهًا قد أصاب خسرو، فتذهب إلى إبي، وتعلم منه ما حل بخسرو. بعد هذه الواقعة، تذهب سالومة إلى ملوك وتخبرها بأمر العريس المتقدم لها وما قاله لها إيي، فتقول لها ملوك إن الأمر متروكٌ لها، إما أن تتزوج، وإما أن تنتظر إبي.. ترحل سالومة عن الحي متوجهةً إلى كيتي، وفي المشهد تظهر رسوماتها المعلقة على جدران حجرتها ويُسمع صوت أبيها منتحبًا وهو ينادي عليها. بعد فترة من الوقت، يظهر شاهين في المقهى، فتتهمه ملوك بأنه وراء اختفاء سالومة، وتتشاجر معه، فيتدخل شاب من رواد المقهى، ويطرده. تعجب ملوك بالشاب الفتي وتتزوجه. تنتهي حكاية ملوك بمشهد تخيلي، تظهر فيه ملوك في ثوب العُرس مُتأبِّطةً ذراع زوجها الشاب، وهي تتطلع إلى جميع أبطال الحكايات، وهم يصفقون لها وينظرون إليها سعداءً.

على الرغم من أن فيلم “مقهى النجمة” مقسمٌ إلى ثلاثةٍ فصولٍ يحكي كل فصل منها حكاية ما، إلا أن الحكايات الثلاث تتداخل معًا بشكل أو بآخر، فالشخصيات تتشارك الأحداث نفسها في كل حكاية، لكن يُسلط الضوء في كل حكاية على شخصٍ بعينه هو بطل هذه الحكاية. كما أن الحكايات تكمل بعضها بعضًا، فهناك أحداث في كل حكاية لا نعلم خاتمتها إلا في حكاية أخرى.
هذا التكنيك الفني في السرد الدرامي يخلق نوعًا من التشويق، ويجعل المشاهد متلهفًا لمتابعة الأحداث الباقية حتى يعلم ماذا حل بهذه الشخصية؟، وما آل إليه هذا الحدث؟
حقق فيلم “مقهى النجمة” نجاحًا كبيرًا وقت عرضه سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي، واستطاع أن يحصد جائزتين من جوائز “بيت السينما الإيرانية” خلال دورته العاشرة عام 2006؛ وهما جائزة أفضل مونتاج، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة كأفضل فيلم. وجائزة “بيت السينما الإيرانية” تعادل جوائز المهرجان القومي للسينما في العديد من بلدان العالم. كما حصل كل من “سامان مقدم” على جائزة أفضل مخرج، و”محمد رضا موئيني” على جائزة أفضل مونتير، و”رؤيا تيموريان” على جائزة أفضل ممثلة من جوائز “حافظ” خلال دورتها العاشرة عام 2007، وهي جائزة تنظمها وتمنحها المجلة الشهرية “عالم الصورة (دنياى تصوير)” المتخصصة في السينما والتليفزيون، وهذه الجائزة تعادل في إيران جائزة “الكرة الأرضية الذهبية” The Golden Globe Awards التي تنظمها وتمنحها “رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية” The Hollywood Foreign Press Association في الولايات المتحدة.
ويعتبر عدد كبير من النقاد الإيرانيين كالناقد المعروف “مسعود فراستي”، رئيس تحرير الفصلية المتخصصة في السينما والمسرح والفنون المرئية “فرم ونقد (الشكل والنقد)”، أن “مقهى النجمة” واحدٌ من أفضل الأفلام الإيرانية في الألفية الثالثة، ويشيد به كثيرًا نظرًا لجرأته وتطرقه إلى موضوعات شائكة في المجتمع الإيراني قلما تُطرح على شاشة السينما أو يُسمح بطرحها في الأساس.
ومن ناحية أخرى يمثل هذا الفيلم عودة الفنانة الإيرانية الكبيرة “أفسانة بايجان” إلى شاشة السينما بعد انقطاع دام سنوات، وهي الممثلة التي أعلنت الاعتزال في 11 يوليو الماضي بعد ملاحقتها قضائيًا من قبل النظام الإيراني بسبب مناهضة الحجاب الإجباري. كما يعد الفيلم حلقة وصل بين جيلين من الممثلين الإيرانيين؛ جيل الكبار ممثلًا في أفسانة بايجان ورؤيا تيموريان، وجيل الشباب ممثلًا في هانية تفاسولي وحامد بهداد وبيجمان بازيغي.
والحقيقة أن “مقهى النجمة” يعد فيلمًا نسويًا خالصًا يطرح من خلال حكاياته الثلاث عددًا من القضايا الخاصة بالمرأة الإيرانية لا تزال قائمة حتى الآن. “فريبا” المرأة المعيلة التي تلقى معاملةً سيئةً من زوج عاطل ومدمن. “سالومة” الفتاة البريئة التي تحلم بالزواج بمن تحب لكن الفقر يحول بينهما. “ملوك” المرأة العانس التي تمل من وحدتها وتريد الزواج برجل حتى وإن كان يصغرها في السن.
هذه النماذج الثلاثة من النساء الإيرانيات لا يزلن موجودات حتى الآن، كما لا يزال طرح قضاياهن على شاشة السينما أمرًا غير مستحب من قبل النظام المتشدد في إيران.
وعلى الرغم من أن السيناريست “پيمان معادي” قد اهتم في فيلمه بالبُعد الإنساني – الاجتماعي من خلال طرح قضايا المرأة الإيرانية كما أسلفتُ القول، إلا أن هذا البُعد قد انتحى منحىً سياسيًا غير مباشر، حيث إن النساء الثلاث مجتمعات معًا يمثَّلن إيران الأرض والوطن والشعب، فإيران وليدة الثورة كانت تتمنى أن يأخذ بيدها آباؤها الشرعيون، فعششت طيور الظلام في ربوعها، والآن تتحسس خُطاها بحثًا عن يد تُخرِجها من الظلمات إلى النور. إيران هي “سالومة” الحالمة، و”فَريبا” المقهورة، و”مُلوك” الباحثة عن السعادة.

زقاق المعجزات El callejón de los Milagros
المعالجة الدرامية التي قدمها “پیمان معادي” في “مقهى النجمة” تتشابه إلى حد كبير مع المعالجة الدرامية التي قدمها السيناريست والكاتب المكسيكي “فيسينتي لينيرو” Vicente Leñero عام 1995 في الفيلم الإسباني الشهير “زقاق المعجزات” El callejón de los Milagros، والمعروف على نطاق التسويق التجاري عالميًا باسم “زقاق المدق” Midaq Alley، المقتبس هو الآخر عن رواية أديبنا العالمي “نجيب محفوظ”.
فيلم “زقاق المعجزات” من إخراج “خورخي فونز” Jorge Fons، ويمثل انطلاقة النجمة المكسيكية المحبوبة ذات الأصول اللُبنانية “سلمى حايك” Salma Hayek في السينما الإسبانية وانتشارها على الصعيد العالمي. استطاع الفيلم اقتناص إحدى عشرة جائزةً من جوائز “آرييل” El Premio Ariel في نسختها السابعة والثلاثين؛ من بينها جائزة أفضل فيلم. وهذه الجائزة تمنحها “الأكاديمية المكسيكية للفنون والعلوم السينمائية”La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas، وهي تعادل في أهميتها وقيمتها جائزة الأوسكار التي تمنحها “الأكاديمية الأمريكية للفنون وعلوم الصور المتحركة” The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. كما رُشح الفيلم وحصل على أكثر من تسع وأربعين جائزةً محليةً ودوليةً.

الفيلم المكسيكي يروى في ثلاثة فصول منفصلة متصلة حكايات ثلاث شخصيات تعيش في إحدى الأحياء القديمة بالعاصمة المكسيكية “مكسيكو”، بالإضافة إلى فصلٍ أخيرٍ يمثل خاتمة الحكايات الثلاث.
الفصل الأول “دون روتيليو (إيرنيستو كروز Ernesto Cruz)” صاحب مطعم صغير متزوج من “دونا يوسيبيا (ديليا كازانوفا Delia Casanova)” منذ 30 عامًا، لكنه يعامل زوجته معاملةً سيئةً بسبب ميوله الشاذة. يعجب روتيليو بفتىٍ وسيمٍ يعمل بائعًا في محل ملابس رجالية يُدعى “خايمي باريديس (إيستيبان سوبيرانيس Esteban Soberanes)”، ويدخل معه في علاقةٍ. يكتشف “تشافا (خوان بيرنال Juan Bernal)” بن روتيليو علاقة أبيه بالفتى، ويضبطهما معًا في وضعٍ حميمٍ في حمام للشواذ، فيهاجم الفتى ويرطم رأسه بالحائط عدة مرات حتى يسقط مضرجًا بالدماء، ثم يلوذ بالفرار إلى الولايات المتحدة معتقدًا أنه قتل الفتى.
الفصل الثاني “ألما (سلمى حايك Salma Hayek)” فتاة جميلة تحب حلاق الحي “أبيل (برونو بيشير Bruno Bichir)”، ويبادلها أبيل المشاعر نفسها. بسبب ضيق ذات اليد، يسافر أبيل بصحبة صديقه تشافا إلى أمريكا سعيًا وراء المال حتى يتسنى له الزواج بحبيبته ألما. في تلك الأثناء يتقدم “دون فيديل (كلاوديو أوبريجون Claudio Obregón)” إلى خطبة ألما، وهو رجل كبير في السن، لكنه ثري ويمتلك محل مجوهرات، فتسعى أم ألما “دونا كاتالينا (ماريا روجو María Rojo)”، قارئة التاروت، إلى إقناع ابنتها بالموافقة على هذه الزيجة التي ستدر عليهما أموالًا كثيرةً. قبل الزفاف، يصاب دون فيديل بسكتة قلبية تودي بحياته. أثناء جنازة دون فيديل تتعرف ألما على رجل وسيم جذاب يُدعى “خوسيه لويس (دانييل كاتشو Daniel Cacho)” يثير إعجابها، لكنها تكتشف أنه قوادٌ يدير بيت دعارة، فتتهرب منه. يطول غياب أبيل، وتشعر ألما بوحشةٍ شديدةٍ، فترحل عن الحي بلا رجعة قاصدةً خوسيه، حيث تسلمه نفسها بمحض إرادتها، وتغدو إحدى بائعات الهوى العاملات لديه. تبلغ دونا كاتالينا الشرطة عن اختفاء ابنتها لكن يعجز الجميع عن العثور عليها.
الفصل الثالث “دونا سوزانا (مارجريتا سانز Margarita Sanz)” ذات الأسنان القبيحة. امرأة متقدمة في العمر، ثرية، وصاحبة العقار القاطن به جميع أبطال الحكايات. يتعلق قلبها بتشافا، لكنه لا ينظر إليها بهذه الطريقة، فتقع في حب الشاب “جويتشو (لويس توفار Luis Tovar)” مساعد دون روتيليو في المطعم، وتتزوجه.
الفصل الأخيرة “العودة” يمثل خاتمة الحكايات الثلاث. يعود تشافا وأبيل من أمريكا، فيذهب تشافا بصحبة زوجته وطفله الرضيع إلى منزل أبويه، فتسعد أمه برجوعه، لكن تظل العلاقة بينه وبين أبيه متوترة، لذا يقرر تشافا الرحيل عن المنزل والسكن في منزل آخر توفره له دونا سوزانا. أما أبيل فيذهب إلى دونا كاتالينا، ويعلم منها أن حبيبته ألما قد اختفت. لا يمض وقت طويل حتى يعرف أبيل مكان ألما وما حل بها، فيذهب إلى لقائها وعتابها عما فعلته. في تلك الأثناء تضبط دونا سوزانا زوجها جويتشو وهو يسرقها، فتدرك أنه تزوجها من أجل أموالها، وتنفصل عنه. يقرر أبيل الانتقام من خوسيه القواد الذي جعل حبيبته بائعة هوى، فيذهب إليه ويهاجمه، لكن خوسيه يطعنه بالسكين عدة طعنات، فيخر أبيل صريعًا بين ذراعي ألما.

على هذا النحو نجد أن السيناريست الإيراني “پيمان معادي” قام بتشذيب المعالجة المكسيكية حتى تتواءم مع البيئة الإيرانية، ولا تقع تحت مقص الرقابة المتشددة على صناعة السينما في إيران. لكن يبقى الخط الأساسي في الفيلمين مقتبسًا عن رواية “نجيب محفوظ”، فشخصية “سالومة” في “مقهى النجمة” هي شخصية “ألما” في “زقاق المعجزات” هي شخصية “حميدة” في “زقاق المدق”. والشخصية النسائية في الأعمال الثلاثة ترمز إلى وطنٍ انحرف به المسار بعيدًا عن أبنائه الشرفاء، فاختطفه الخادعون والطامعون فيه ينتهكوه ويستنزفون خيراته.
أما إذا أتينا إلى الشخصية الرجالية في الأعمال الثالثة، سنجد أن “إبي” في “مقهى النجمة” هو “أبيل” في “زقاق المعجزات” هو “عباس الحلو” في “زقاق المدق”. وهذه الشخصية ترمز إلى أبناء الوطن الشرفاء الحالمين بغدٍ أفضل؛ هم العاشقون والمُضحُّون والباسلون والمدافعون عن الأرض والعِرض، هم الصابرون والساعون والباسمون في وجه القادح قبل المادح، هم من يلقون بأرواحهم إلى التَّهلُكة في سبيل حرية وطنهم، هم رجالات كل عصر ومِصر المجهولون الخالدون الباقون في ذاكرة التاريخ اللامحكي واللامدون.
وبعيدًا عن الشخصيات الرئيسة في الفيلمين، دارت الأحداث في كلا العملين بإحدى الأحياء القديمة بالعاصمة الإيرانية “طهران” والعاصمة المكسيكية “مكسيكو”، مثلما دارت أحداث رواية محفوظ في “زقاق المداق” الواقع في قلب العاصمة المصرية “القاهرة”.
حميدة (زقاق المدق)
بطبيعة الحال كانت السينما المصرية سبَّاقة إلى تقديم رواية “زقاق المدق” على شاشتها العريقة قبل سنوات طويلة من إقدام السينما المكسيكية والإيرانية على تقديم هذه رواية في عملٍ فنيٍ.
ظهر أفيش الفيلم باسم “حميدة”، لكن تتراته حملت اسمي “حميدة” و”زقاق المدق”. تم إنتاج الفيلم عام 1963، وصاغ له السيناريو والحوار الكاتب الكبير “سعد الدين وهبة”، وأخرجه مخرج الروائع وصانع النجوم “حسن الإمام”، ولعبت بطولته نُخبة من ألمع النجوم المصريين في ذاك الزمان: شادية (حميدة)، صلاح قابيل (عباس الحلو)، يوسف شعبان (فرج إبراهيم)، حسن يوسف (حسين كِرشة)، عقيلة راتب (الست عديلة البلانة – أم حميدة)، حسين رياض (الأستاذ درويش)، محمد رضا (المعلم كِرشة)، عدلي كاسب (السيد سليم علوان)، عبد الوارث عسر (عم كامل)، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الآخرين يأتي على رأسهم: سامية جمال، عبد المنعم إبراهيم، توفيق الدقن، ثُريا حلمي، سمير صبري. أنتج الفيلم “رمسيس نجيب (الشركة العربية للسينما)”، ووضع موسيقاه التصويرية “عليّ إسماعيل”. ويعد “زقاق المدق” واحدًا من أروع أفلام السينما المصرية في عصرها الذهبي.

فيلم “زقاق المدق” في نسخته المصرية يتسق مع الرواية من حيث تسلسل الأحداث وتطور الشخصيات، فقد دون “نجيب محفوظ” روايته في ثوب سردي واحد وليست في فصول منفصلة معنونة بأسماء أبطالها مثلما جاء في الفيلمين المكسيكي والإيراني، ومن المؤكد أن السيناريست “پيمان معادي” شكل رؤيته الدرامية بناءً على الفيلم المكسيكي، ولم يطلع على الرواية الأصلية بقلم محفوظ.
وعلى الرغم أن الفيلم المصري يتناغم مع الرواية شكلًا ومضمونًا كما أسلفتُ القول، إلا أن السيناريست “سعد الدين وهبة” والمخرج “حسن الإمام” قد غيرا النهاية على النحو التالي:
حينما يدخل عباس وحسين الملهى الذي تعمل فيه حميدة، يجدانها في أحضان عسكري إنجليزي، فيُلقي عباس على العسكري زجاجة بيرة فارغة، فيتفاداها العسكري ويطلق الرصاص عليه، لكن حميدة تُلقي بنفسها على عباس، وتتلقى الرصاصة بدلًا منه. يتزامن إطلاق الرصاص مع إطلاق صفارات الإنذار معلنةً بدء غارة جوية، فيسود الهرج والمرج أرجاء الملهى، ويهرع الجميع خارجين منه. يحمل عباس حميدةً يصحبه حسين، ويركضان بها نحو زقاق المدق وهي بين الحياة والموت. ما إن يصل ثلاثتهم إلى الزقاق، وتبصر حميدة أنحاء الزقاق وبيوته وحوانيته حتى تلفظ أنفاسها الأخيرة. يتجمع أهل المدق حول حميدة وعباس، وتصيح أم حميدة: “حميدة بنتي ماتت”.
على هذا النحو يكون وهبة والإمام قد غيرا نهاية الرواية من مقتل عباس الحلو على أيدي العساكر الإنجليز إلى مقتل حميدة، وذلك على عكس نهاية الفيلم المكسيكي المتوافقة مع نهاية الرواية.
ويبدو أن وهبة والإمام قد جعلا موت حميدة نوعًا من العقاب الإلهي جراء ما اقترفته في حق نفسها وحق خطيبها عباس، غافلين ما ترمز إليه حميدة وما يرمز إليه عباس، فالوطن يزدهر وينتكس نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، لكنه لا يموت، أما أبناؤه الشرفاء فهم من يضحون بأرواحهم في سبيل حريته ورفعته.

خاص وكالة رياليست – د. محمد سيف الدين – دكتوراه في الأدب الشعبي الفارسي، وخبير في التاريخ والأدب الإيراني – مصر.