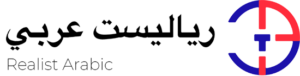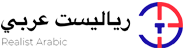مرَّت “صفقة القرن” كما سابقاتها، والكأس المرّ الذي اعتاد العرب تجرّعه، وكأنّهم إستساغوه، فما عادوا وجدوه علقمًا. الصفقة التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية، لم تراعِ مبادئ “الديمقراطية” الأميركية كما لم تحترم القرارات الدولية ولا صانت حق الشعوب بتقرير المصير. أمّا الشعوب التي استفاقت يومًا على حقّها في التصدي للعدوان بالمقاومة والإنتفاضتين، لطالما عانت بدورها الأمرّين: مرارة واقع السياسة الدولية التي يفرضها سلطان القوى العظمى على الرغم من إفتقارها للمشروعية؛ ومرارة السياسات الداخلية التي تستأثر بها السلطات المحلية في غياب أنظمة حكم تكفل الديمقراطية، حتى باتت الشعوب في سبات، سيّان عندها القمع أكان محليًا أم دوليًا، في ظل تأقلمها مع واقع إفتقارها للحقوق الإنسانية كما هو شأن حقّها بتقرير المصير.
الديمقراطية في تراجع، ليس في الشرق الأوسط وحسب أو في الدول العربية على سبيل الحصر، وإنّما عالميًا وفقًا لأحدث إصدار لمؤشر الديمقراطية من “وحدة المعلومات الاقتصادية” (EIU)، في نتيجة عالمية هي الأدنى منذ إقرار المؤشر في العام 2006. هذا الاستطلاع السنوي الذي يقيّم حالة الديمقراطية في 167 دولة، بناءً على خمسة تدابير تعنى بالعملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية؛ تحتل “أم الديمقراطية” الولايات المتحدة فيه المرتبة الخامسة والعشرين، وتجاورها إسرائيل في المرتبة الثامنة والعشرين، بتصنيفها “دول ديمقراطية كاملة”. أمّا الواقع فيشهد والحق يقال، أنّ لا الولايات المتحدة وإسرائيل دولًا تقرُّ بمبادئ الديمقراطية، ولا الدول العربية ولا كانت يومًا الصين.
وإن كان من المستغرب أن يُزَج بإسرائيل في الصّدارة مع الدول كاملة الديمقراطية، فليس بالغريب أن تحتل الصين المرتبة 153 من أصل 167 بتصنيفها نظامًا إستبداديًا على الرّغم من دورها الرّائد في الأمم المتحدة، حيث لا يشفع بالصين كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وما لها في ذلك من كلمة فصل في قضايا الأمن والسلم الدوليين في ظل ما تعكسه سياساتها الداخلية والخارجية من ممارسات تناقض مبادئ الحريات العامة وحق الشعوب بتقرير المصير. ومّما يعنينا في التطرق إلى الشأن الصيني، إظهار التقارب النموذجي ما بين السياستين الإسرائيلية والصينية، تجاه القضية الفلسطينية وما يشابهها إلى حد كبير في القضية التيبتية؛ على أن نبيّن بنتيجة ذلك التباين في الموقف الأميركي من القضيتين، لجهة تأييد السياسة الإسرائيلية ومناهضة السياسة الصينية بذريعة الديمقراطية، فننقض ما تستند إليه الولايات المتحدة في مبادرتها الداعمة لإسرائيل.
نلحظ عند إستقراء السياسة الخارجية الأميركية، أنّ المعيار الحقيقي الثابت نهجه في ثقافة السياسة الدولية للولايات المتحدة، يتمثّل بـ”المصالح الأميركية” وليس الديمقراطية. وإنّنا إذا عمدنا إلى دراسة القضايا الدولية المختلفة التي تشكو فيها الشعوب من غياب أو إختلال موازين الديمقراطية، لوجدنا أنّ السياسة الخارجية الأميركية تتفاوت ما بين كونها داعمة أو ردعية لسياسات الدول الإستبدادية، بتفاوت مصالحها مع هذه الدول المعنية. ففي حين بادرت الولايات المتحدة إلى مباركة التجاوز الإسرائيلي لمبادئ الديمقراطية وكانت شريكة بموجب صفقة “ترامب – نتنياهو” في الإنتهاك الصريح لقرارات الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي الذي يكفل للشعب الفلسطيني حقه بتقرير مصيره؛ لم تزل الولايات المتحدة في المقلب الآخر من العالم، تحارب الصين بشأن السياسة الإستبدادية التي تمارسها على أقاليم الحكم الذاتي للأقليات العرقية، وتسيّر بوارجها الحربية بانتظام في بحر الصين الجنوبي، في تحدٍّ عسكري رادع للصين دفاعًا عمّا تسميه “المصالح الدولية” للفيليبين، فيتنام، بروناي وماليزيا في مواجهة الصين التي تسيطر على الجزر في المنطقة لتأكيد سيادتها عليها.
في تحليل الواقع السياسي المتجرد عن المصالح الأميركية، تتماثل السياسة الخارجية الصينية والإسرائيلية من حيث النهج السلوكي الممارس على الإقليم استنادًا إلى الإعتبارات المادية لنظرية الواقعية السياسية، وهي المتمثلة بالصراع لأجل السيطرة وإرتباطه بهاجس الأمن والبقاء، وما يقترن به غالبًا من قوة سياسية مرفقة بطابع الأنانية من حيث السعي لتعزيز القوة على حساب مصالح الآخرين وحقوقهم. وتشتمل هذه الإعتبارات كذلك على حالة من الفوضى الخارجية التي تخلّفها التحديات الدولية، والفوضى المحلية التي تخلقها السياسة نفسها الهادفة لإسقاط النظام القائم وبناء نظام جديد يتوائم مع الرؤية السياسية للدولة ويحقق أهدافها. وبالمثل أيضًا، تشترك السياستين الصينية والإسرائيلية في إرتكاز سلوكهما السياسي عمومًا والإقليمي منه خصوصًا على قاعدة عقائدية تتمحور حول هويتها الإثنية التي تنطلق منها في إصدار أحكام وسياسات جماعية. وفي دراسة نموذجية مقارنة لقضيتي التيبت وفلسطين، نلحظ هذا التماثل من خلال معايير عدة، أبرزها الآتي:
الدافع الإثني: تحتج الصين بأن هضبة التيبت إقليم يتبع لسيادة جمهورية الصين الشعبية تاريخيًا، بنتيجة الروابط الإثنية التي عقدها أسلاف القبائل التيبتية مع الـ”هان” الصينية منذ ما قبل العصر المسيحي، بالرغم من واقع تأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام 1949؛ في حين كانت الشعوب التيبيتية تتمتع باستقلال إقليمها وسيادتها كإمبراطورية منذ القرن السابع ميلادي، وقد إتخذت حدودها الحالية منذ القرن الثامن عشر. وبدورها، تتذرع إسرائيل التي تأسست سنة 1948 بملكيتها “الإثنية” لأرض “دولة فلسطين”، والتي تعود لما يزيد عن ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح، بأنها “أرض الميعاد” التي يعتقد بأنّ الرب وعد بها للنبي إبراهيم ونسله؛ في حين عرفت “فلسطين” تاريخيًا أرضًا للفلسطينيين واتخذت حدودها المعروفة قبل الإحتلال منذ عام 1917.
سياسة الإحتلال العسكري: تصوّر الصين سياستها الخارجية تجاه التيبت بما أسمته “التحرير السلمي” للتيبت وشعبها بإعتباره ذو أصول عرقية صينية، لحماية السيادة الصينية والوحدة الوطنية من الغزو الإمبريالي؛ غير أنّ هذا “التحرير القسري” شكّل في الواقع إحتلالًا عسكريًا للتيبت جوبه بانتفاضات شعبية ومقاومة الجيش التيبتي على مدى عشر سنوات في التبت الشرقية راح ضحيته 87000 تيبتي في منطقة لاسا وحدها، فاستدعى إنسحاب الحكومة التيبتية ومعها أغلبية الشعب التيبتي إلى الهند هربًا من الجور الصيني. وكذلك إسرائيل، تجد في إحتلالها لفلسطين، “إستعادة لأرضها” أرض الميعاد الموعودة عقائديًا لبني إسرائيل وتحريرها بالقوة من الحكم الفلسطيني العربي، تحت إعتبار أن العرب المسلمون قاموا تاريخيًا بإحتلال أرض اليهود المقدسة.
نزع السيادة: مع تأسيس الكيان الصهيوني على إقليم دولة فلسطين، ونيله الإعتراف الدولي بعد مباركة الدول العظمى لقيام الدولة رغم مخالفة القانون الدولي، أصبحت الدولة الفلسطينية ذات سيادة منتقصة، ليتم الاعتراف بفلسطين فقط كدولة قانونية بحكم القانون وإنّما ليس بحكم الواقع، باعتبار أن السلطة الفلسطينية تمثل الحكومة الشرعية لإقليم ليس لها سيطرة فعلية عليه. على النحو ذاته، كان من أثر إحتلال التيبت ووضع الإقليم تحت السيادة الصينية، أن نزعت السيادة عن دولة التيبت بنفي الحكومة التيبتية الى الهند؛ وفي حين فقدت السلطة التيبتية الشرعية السيطرة على الإقليم، أعلنت الصين التيبت إقليم حكم ذاتي وعيّنت له حكومة خاضعة لولايتها.
سياسة التطهير العرقي: لجأت الصين إلى سياسة توطين الصينيين في التيبت، لمحو الهوية التيبتية وجعلهم أقلية بحيث فاق المستوطنون الصينيون في التيبت عدد التبتيين بنسبة 7 إلى 1؛ وقد فرضت الصين سياسة الإجهاض والعقم بحق التيبتيين، كما وقتل ما يقدّر بـ1.2 مليون من أصل 6 ملايين تيبتي منذ غزو التيبت. بالمثل، طبّقت اسرائيل سياسة التطهير العرقي بهدف إلغاء الهوية الفلسطينية وتثبيت الوجود الإسرائيلي عبر إعادة توطين اليهود في الدولة الإسرائيلية المنشأة على أرض فلسطين، وهو ما أكّد عليه المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي في كتابه “التطهير العرقي لفلسطين” عن عملية قلع الجذور الفلسطينية لحوالي 800,000 فلسطيني.
سياسة التهجير: عملت الصين بالفعل على قلع جذور الشعب التيبتي من أرضه من خلال سياسة التهجير القسري التي أطاحت بموجبها بحكومة التيبت ودفعت بالرئيس الروحي الأعلى للتيبتيين الدالاي لاما إلى المنفى الذاتي في الهند وما رافق ذلك من تهجير نحو 100,000 تيبتي عام 1959. ومن ناحيتها، تسلحت إسرائيل بسياسة التهجير القسري للشعب الفلسطيني خلال نكبة 1948، نتيجة العمليات العسكرية التي قادتها حينها الميليشيات الصهيونية إبان “خطة داليت” لإزالة الفلسطينيين من أرضهم وإعلان دولة إسرائيل، فتم ترحيل أكثر من نصف عدد الفلسطينيين الى الدول العربية، فيما هُجّر آخرون من قراهم لمناطق أخرى داخليًا.
سياسة العزل ومنع حق العودة: عَزلت الصين التيبت فعليًا عن العالم، فمنعت على مدى سنوات طويلة أي سفر من أو إلى إقليم التيبت، لتعود وتأذن ذلك بتصريح خاص من الصين؛ وقد حظر على التيبتيين العودة إلى وطنهم وزيارة أراضيهم تحت خطر التعرض للإعتقال وحتى ما يخشونه من القتل. على نحو مشابه، قامت إسرائيل بعزل الضفة الغربية وغزة عن باقي الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سيادتها، حيث عمدت الى إتخاذ إجراءات تعسفية ومنها اقفال مناطق تواجد الفلسطينيين وحظر تجولهم؛ كما وعززت من مفاعيل سياسة العزل بموجب “القانون العسكري 1948-1966” الذي يهدف إلى منع المهجرين من العودة لمنازلهم وقراهم.
مصادرة الأراضي وتدمير دور العبادة: في سعيها لمحو الهوية التيبتية، قامت الصين بعملية هدم واسع النطاق لمنازل التيبتيين والمعابد والمواقع الأثرية البوذية التيبتية، فقد دمّر أكثر 6000 من الأديرة التيبتية منذ 1949 فيما مُنع السكان التيبتيين من ترميم منازلهم أو بناء غيرها. بدورها دمرت إسرائيل حوالي 531 قرية فلسطينية وهجرت سكانها بشكل كامل، حيث عمدت إلى مصادرة أراضيهم بفعل القوانين التعسفية التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية لتوصيف الفلسطينيين المهجرين في الداخل بـ”الغائبين الحاضرين” مما سهّل عملية تملّك الأرض الفلسطينية وترحيل المالكين عنها؛ ومن أبرز هذه القوانين “قانون ملكية الغائبين” و”قانون حيازة الأراضي”.
السياسة التوسعية والمستوطنات: ترتكز الصين في سياستها التوسعية إلى رؤيتها الإثنية لمحورية دورها التاريخي كقوة عظمى وسلطة مركزية في العالم، وأكثر ما تتبلور به هذه الرؤية اليوم هو التوسع الإقتصادي من خلال إعادة أمجاد طريق الحرير التجاري وامتداده البرّي والبحري في آسيا وصولًا لأوروبا؛ إلى جانب السياسة التوسعية السياسية والعسكرية التي تقودها في ضم الأقاليم المجاورة مثل تايوان، هونغ كونغ والتيبت. بالمثل، تنطلق إسرائيل في سياستها التوسعية من العقيدة الصهيونية والطابع الإستيطاني للمجتمع الإسرائيلي ليكون وطن قومي للشعب اليهودي؛ غير أنّ هذا التوسع الإحتلالي للكيان الإسرائيلي لطالما كان مدعومًا بإعتراف دول عظمى بدءًا بوعد بلفور سنة 1917، مرورًا بقرار التقسيم عام 1947، ووصولًا لصفقة القرن.
السياسة القمعية ونهج التمييز والعنصرية: تنتهج الصين سياسة كيدية بحق التيبتيين الذين لم يهاجروا لخارج التيبت، بمنعهم من ممارسة الشعائر الدينية أوحمل رموزها؛ وحرمانهم من حقهم بالتنقل والسفر سواء بالحجز على جوازات السفر أو منع إصدارها، كما ومنعهم حقهم بالتعبير عن الرأي والتظاهر، تحت طائلة الإعتقال. وبدورها لم ترحم إسرائيل الفلسطينيين من السياسة القمعية المتمثلة بأوجه التمييز والإقصاء والتهميش في القطاعات المختلفة والشؤون الإجتماعية، المعيشية والثقافية؛ وما يضاف إليها من التوقيفات الإحتياطية والتعسفية، والقيود الواقعة على الرأي العام وما يتعرضون له من ضرب أو قنص في المظاهرات السلمية.
ولعلّ أبرز ما يشهد في دراسة الحالتين الآنفتين، هو واقع غياب الحماية الدولية للشعبين التيبتي والفلسطيني على السواء، إن لناحية تقصير المجتمع الدولي في تأمين الحماية الإنسانية اللازمة للمدنيين، وصون حقوق وحريات التيبتيين والفلسطينيين بوجه السياسات الإحتلالية الجائرة والقمعية؛ وما يستوجبه ذلك من إتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الردعية الملزمة للصين كما لإسرائيل لوقف إعتداءاتها وإنتهاكاتها للقانون الدولي والمعاهدات الدولية. وحيث أنّ مسؤولية الحماية الدولية تقع بشكل رئيسي على الدول المصادقة على المعاهدات وبالأخص منها إتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولات المرفقة، فإن تخلف الدول عن مسؤوليتها بالردع والحماية، تساهم بشكل غير مباشر في استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني والتيبتي.
موقف الولايات المتحدة الأميركية: لم تتوانى الولايات المتحدة عن التفاني بمسؤوليتها في الحماية الدولية بمواجهة الصين وسياساتها التعسفية في شرق آسيا عمومًا والتيبت خصوصًا. فلطالما صرّح البيت الأبيض عن قلقه، محذّرًا الصين بشأن السياسات اللاديمقراطية تجاه التيبت ومبديًا المخاوف بشأن القيود التي تفرضها الصين على الحريات الدينية وضرورة المحافظة عليها ثقافيًا ولغويًا. أما إجرائيًا، تنتهج الولايات المتحدة سياسة إحتوائية بوجه سياسة الصين التوسعية، وقد اتخذت آليات ردعية كان أبرزها توقيع الرئيس الامريكي ترامب مؤخرًا على “قانون الوصول المتبادل الى التبت” في محاولة للضغط على الحكومة الصينية من خلال رفض دخول المسؤولين الصينيين إلى الولايات المتحدة لإعتبارهم مسؤولين عن تقييد الوصول إلى التيبت.
أما بمواجهة إسرائيل، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تحوّل الموقف الأميريكي من سياسة الردع الواجبة إنسانيًا ودوليًا إلى سياسة داعمة لإسرائيل لازمة للولايات المتحدة سياسيًا؛ وانتفت أمام المصالح الأميركية في الشرق الأوسط – التي يحققها وجود الدولة الإسرائيلية كنظام قوة إقليمي وكيان صهيوني عسكري في المنطقة- مسؤولياتها الدولية بمجابهة السياسات المناقضة للديمقراطية ومناصرة حق الشعوب بتقرير مصيرها. وخير دليل هو ما قدمته صفقة القرن باعتبارها طرح أميركي لعملية سلام في المنطقة، وما تمثله من أداة لتنفيذ السياسة التوسعية لإسرائيل على حساب مصالح الفلسطينيين، ودون اعتبار لرأيهم وحقهم بتقرير المصير.
من هنا، نعود لنتبيّن من حقيقة الموقف الأمريكي الداعم للتيبت، القائم على مصالحها في ردع الصين عمومًا باعتبارها أكبر دولة منافسة إقتصاديًا للولايات المتحدة في العالم، وامتلاكها لأحد أعلى معدلات الإنفاق العسكري. وما يضاف إليه على وجه الخصوص من مصالح الولايات المتحدة الجيوسياسية في التيبت من حيث موقعها الجغرافي وما تمثله من باب إلى جنوب آسيا والجانب الغربي من الصين، وكونها مصدرًا دائمًا للحساسية لبكين؛ وهذا ما يجعل من القضية التيبتية ورقة رابحة بيد الولايات المتحدة لتطييع الصين وتهديدها بالعواقب.
الرؤية الرسمية التيبتية لحل الأزمة: بعد إدراك إستحالة الإستقلال التيبتي الكامل، تحوّل الرئيس الروحي للتيبت الدالاي لاما إلى الدعوة لحل يكمن بين الإستقلال التام والحالة الحالية من حرمان الحقوق والاضطهاد، على أن يستتبع هذا الحل استقلالًا تبتيًا حقيقيًا بإعتراف الدستور الصيني؛ يمكَّن التبتيون في ظل إنضواء التيبت تحت حكم جمهورية الصين الشعبية من تولي الحكم ديمقراطيًا والحفاظ على هويتهم الثقافية، ويكون للصين في تلك المرحلة الإنتقالية الحفاظ على وجود عسكري في المنطقة والتعامل مع العلاقات الدولية والدفاع.
الرؤية الفلسطينية لحل الأزمة: من جهتها، تطالب السلطات الفلسطينية اليوم بالمناطق التي كانت احتلتها إسرائيل سنة 1967 لإقامة دولة مستقلة بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، رافضين الخضوع لأي حكم أو سيادة إسرائيلية. فقد أيقن الفلسطينيون في ظل الواقع السياسي الراهن إستحالة تحرير فلسطين وإستقلالها بشكل تام عن الإحتلال الإسرائيلي، أمام ما أظهرته الدول من إعتراف رسمي داعم لدولة إسرائيل، وما أبداه العرب من تقاعس الدول العربية عن التوحد لمحاربة التدخلات غير الشرعية في السيادة الفلسطينية. أما وبعد رفض صفقة القرن، أعلنت السلطة الفلسطينية قطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة، مع التهديد بإيقاف التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ وقد دعا الرئيس عباس جميع الفصائل الفلسطينية، وخصومه في حركة حماس، إلى الإتحاد ووضع استراتيجية مشتركة لمواجهة “صفقة القرن”، كما نادى الدول العربية لتقديم الدعم.
في خلاصة الأمر، تبدو لنا الديمقراطية الأمثل فيما عبرّ عنه مارتن لوثر كينغ بقوله: “الديمقراطية ليست إستفتاء بالأغلبية، لو استفتي الأميركيون لظلّ السود عبيدًا”. فإن السياسة لا يمكنها أن تنفصل عن الواقع، وكذلك الديمقراطية لا يكون لها أن لا تراعي الوضع الراهن الذي بات يترتب عليه حقوق وواجبات تجاه “الشعب” الموجود سواء كان ذو إنتماء تيبتي، صيني، فلسطيني أم إسرائيلي. فحيث بات القانون الدولي يكفل حقوق المجتمع الإسرائيلي كشعب، لم يعد بالإمكان محاربة إسرائيل قانونيًا لزوالها ولا إعادة الحق لأصحابه باستعادة إقليم فلسطين كاملًا للفلسطينيين إلا إذا اختارت فلسطين مجابهة الإحتلال بالمثل عسكريًا نحو التحرير.
وعليه، فإنّ الديمقراطية المنشودة ههنا ليست تلك التي يستفتى بها الشعب الفلسطيني بشأن صفقة القرن، للوقوف على حكمه أو مدى تأييده للصفقة من عدمه؛ وإنّما هي الديمقراطية المقترنة بالعدالة والإنصاف وضمان حقوق الفلسطينين المشروعة في الأرض، في الهوية، في الحكم، في تقرير المصير، وفي احترام حرياتهم؛ بالإضافة إلى السماح لهم بحق العودة كشرط أساسي لتحقيق السلام والعيش المشترك. مما تقدّم، لا يمكن إعفاء إسرائيل من التزاماتها الدولية أو من العواقب المترتبة على سياساتها الإستبدادية بحق الفلسطينيين؛ وقد آن للسلطة الفلسطينية بناء إستراتيجية وطنية؛ وللمجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني.لارا الذيب- باحثة قانونية إستراتيجية، خاص لوكالة أنباء “رياليست”