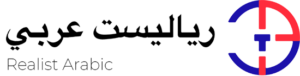دمشق – (رياليست عربي). بعد مرور عام على انهيار حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لا تزال سوريا تواجه مهمة شديدة التعقيد تتمثل في إعادة بناء قواتها المسلحة، وهي عملية يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها عنصرا محوريا في استعادة الاستقرار السياسي ومنع الانزلاق مجددا إلى صراع واسع النطاق.
ولعقود طويلة، شكّل الجيش والأجهزة الأمنية أدوات لبقاء النظام، وارتبط اسمهما بالقمع والسيطرة الداخلية. وتسعى الحكومة الانتقالية اليوم إلى تفكيك هذا الإرث وبناء عقيدة عسكرية جديدة تقوم على الولاء للدولة ومؤسساتها، لا للأفراد أو الفصائل.
وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الضباط في مدينة حلب: «بدأنا بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية لبناء جيش يليق بسوريا، جيش يمثل الأمة وقادر على مواجهة التحديات المقبلة»، مشيرا إلى اعتماد قواعد جديدة للانضباط والسلوك العسكري.
غير أن محللين يحذرون من أن هذه العملية ستكون طويلة وهشة، في ظل مشهد أمني لا يزال شديد التفتت بعد سنوات من الحرب، وتعدد الفصائل المسلحة، وتضارب المصالح الإقليمية، وضعف القدرات المؤسسية للدولة.
وتشمل التحديات الرئيسية تدقيق خلفيات عشرات الآلاف من المجندين الجدد، ودمج مقاتلين سابقين من فصائل المعارضة، وكذلك القوات الكردية في الشمال الشرقي، إضافة إلى حسم مستقبل العتاد العسكري الروسي، وإعادة بناء الثقة مع الأقليات الدينية والعرقية.
وقالت كارولاين روز، مديرة برامج الشؤون العسكرية والأمن القومي في معهد نيو لاينز: «إذا فشلت سوريا في دمج الجماعات المسلحة ضمن جيش وطني موحد، فإنها تخاطر بالتفكك وعودة عدم الاستقرار»، محذرة من أن غياب التوحيد قد يعيد البلاد إلى صراع داخلي.
وكان سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر عام ألفين وأربعة وعشرين قد أدى فعليا إلى تفكك البنية العسكرية القديمة، حيث فر آلاف الجنود أو اختبأوا أو سلموا أسلحتهم. وفي أعقاب ذلك مباشرة، شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة قالت إنها دمّرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الاستراتيجية السورية، ما ترك السلطات الجديدة بقوات محدودة الإمكانات.
وقام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بحل الجيش السابق رسميا. وتضم حركته، هيئة تحرير الشام، التي قادت عملية إسقاط الأسد، نحو أربعين ألف مقاتل، وهو عدد لا يكفي لضبط الأمن في البلاد بأكملها. ولتعويض هذا النقص، سارعت دمشق إلى توسيع عمليات التجنيد ودمج عدة فصائل مناهضة للنظام السابق ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
غير أن هذا التوسع السريع جاء مصحوبا بمخاطر، إذ يشير محللون إلى ضعف آليات التدقيق، والضغوط الاقتصادية التي تدفع شبانا كثر إلى الالتحاق بالقوات الجديدة، إضافة إلى الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير المقاتلين الأجانب. وقد حذرت دول غربية من منح هؤلاء مناصب قيادية، وهو موقف قال الشرع إنه يتفق معه علنا.
وعلى الصعيد الخارجي، تشهد السياسة العسكرية السورية تحولا تدريجيا. فبينما تبقى روسيا موردا رئيسيا للسلاح، تسعى دمشق إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة و**تركيا** و**السعودية** و**قطر**. ووفق تقارير، وسعت واشنطن التعاون الاستخباراتي، فيما بدأت تركيا تدريب طلاب عسكريين سوريين بموجب اتفاق دفاعي ثنائي.
ورغم تنامي الانخراط الدولي، لا تزال الشرعية الداخلية موضع شك. فقد أضعفت تقارير عن انتهاكات ذات طابع طائفي ارتكبتها قوات أمنية في المناطق الساحلية والجنوبية ثقة الأقليات، في حين تستمر التوترات مع قوات سوريا الديمقراطية رغم وجود اتفاق رسمي على الاندماج المستقبلي.
ومع دخول سوريا عامها الثاني بعد سقوط الأسد، تبقى إعادة بناء جيش وطني موحد ومحترف حجر الزاوية في عملية إعادة بناء الدولة، وأحد أصعب اختبارات المرحلة الانتقالية.